
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
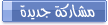
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
شبه عضو
-- أخ لهلوب --
|
في نقد العلمانية والديمقراطية أو مشكلتا الدين والدولة: ياسين الحاج صالح 2007/06/14 في هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يتميز المتابع تيارين عريضين في أوساط "الإنتلجنسيا" السورية: تيار يعتبر أن الاستبداد هو المشكلة، والديمقراطية، من ثم، هي الحل؛ وتيار آخر يعتبر أن الأصولية أو الإسلام السياسي هو المشكلة، وأن الحل هو العلمانية. لا يستنفد هذان التياران اتجاهات المثقفين وناشطي الشأن العام السوريين، بيد أنهما عنوانان إيديولوجيان بارزان، ربما الأبرز اليوم، لانحيازاتهم الفكرية والسياسية.
جون دارننك _سابقا_ **********
-------------------------------- dont ever kick sleep lion |

|
|
|
#2 |
|
شبه عضو
-- أخ لهلوب --
|
فمفهوم الفصل بين الدين والدولة لا يقف في وجه تديين الدولة المحتمل، وهو الفهم المتداول، بل كذلك في وجه تدويل الدين أو تسييسه. وغياب مفهوم الفصل، وثقافة الفصل، يسهل للدولة استتباع الدين، ويسهل لنخب دينية أن تجاهد للسيطرة على الدولة، وجعلها دولة دينية.
أول عقلنة الدين، إذن، فرزه عن غيره وتمييز نصابه الذاتي. هذه عملية فكرية، يقوم بها مثقفون، وهي وجه أول لتكوّن ثقافة الفصل، أما الوجه الآخر فيعكس الانفصال الواقعي و"يروي قصته" ثبته ويجعله غير عكوس. والخلاصة أنه يلزم تأسيس الدين كمفهوم مستقل، أي تحديد مجاله ونوعية الخبرات والأفكار والعلاقات التي تخصه وتنضوي تحته، كشرط للانفصال بين الدين والدولة. وهو ما عنيناه بالقول إنه يتعين إجراء الفصل في الذهن أولا، من أجل إجرائه في الواقع تاليا. والتتابع هذا منطقي وزمني في آن. وحتى لو افترضنا أن الفصل الواقعي بين المفهومين والمجالين تحقق بطريقة ما، فإن تحققه في الثقافة هو وحده ما يصونه ويجعله غير عكوس، فوق إضفاء الاتساق عليه ومنحه قيمة إيجابية كما ذكرنا. *** وتعني عقلنة الدولة إعادة بناء مفهومها كمقر للسلطة العمومية، ما يقتضي بالضرورة فصلها عن كل من العصبيات الدينية والدموية، وعن الطبقات الاجتماعية، كما عن القوة العسكرية. وهو ما يقتضي أيضا فرزا في الذهن، أي في الثقافة، للدولة عن ما هو ليس هي، وتمييزا لها بقوام ذاتي مستقل. وقوام الدولة هو السلطة، والقيادة والسياسة، واللحظة الراهنة. فهي مزيج من القوة والحنكة، حساس للزمن، ولا يمكن تحديد نسبة كل منهما فيه سلفا. الفرز والتمييز هذين، كبعدين لعقلنة الدولة، لا يواجهان استيلاء الدين المحتمل على الدولة، بل كذلك استيلاء الدولة على الدين أو استخدامها له. ومن شأن توفر ثقافتنا على مفهوم يضبط الفصل وينظمه أن يكون أساسا لسلوك وممارسات اجتماعية وسياسية وقانونية وأخلاقية وحتى دينية، تمنع الخلط بين الدائرتين، وتصون استقلالهما معا. ونريد من الكلام على مفهوم الانفصال القول إن مدارا أساسيا للجهد اللازم في شأن العلاقة بين الدين والدولة هو الثقافة والفكر. أي إعادة تنظيم وهيكلة عتادنا العقلي بحيث ينتج من المعاني والقيم والدلالات والتيارات الفكرية ما يميز كلا من المفهومين، ويجعل استقلال الدولة والدين أمرا طبيعيا ومرغوبا، وترابطهما أمرا شاذا وغير مقبول. على أن ثقافة الانفصال، إن صح التعبير، لا تقتصر على مفهوم الانفصال ذاته، بل هي تكثيف لمجمل تجربة الانفصال (بأبعادها السياسية والاجتماعية والروحية، وبملابساتها التاريخية الخاصة وطابعها التراجيدي المحتمل)، وهي تملك عقلي وقيمي لوقائعها وعملياتها وتناقضاتها. بعبارة أخرى، ثقافة الانفصال هي ثقافتنا بقدر ما تنتظم حول انفصال مجالي الدين والدولة. وبهذا المعنى، لا تكتمل ثقافة انفصال الدين والدولة إلا مع إنجاز انفصالهما الواقعي. وإن كان لا ينبغي لذلك أن يلغي الوظيفة الاستباقية للثقافة، أعني الجهود الفكرية والروحية لتمييز مفهومي الدين والدولة بأوضح صورة ممكنة. *** في حالنا الراهن "الدين" ليس دينا، و"الدولة" ليست دولة. ونتحدث عن مشكلة دينية لأن الدين، مفهوما وممارسة وعلاقات، بلا شكل ولا نظام، مشتبه، مختلط، تدخل فيه أشياء ليست من نصابه، ويدخل في أشياء ليست من مجاله. وعبارة "الإسلام دين ودولة" وجه من وجوه هذا الاختلاط وفقدان الشكل. وهي في الواقع عبارة متناقضة منطقيا، تخرج الإسلام من مقولة الدين، وتفرده عن أي شيء آخر نعرفه، فتجعله غير مفهوم. فالإسلام ليس دينا مثل المسيحية واليهودية والبوذية .. إنه "أوسع وأكبر من كلمة دين" حسب السيد يوسف القرضاوي. ما هو؟ إنه "دين ودولة، ومصحف وسيف، وسلطان وقرآن.." في عبارة حسن البنا. أي مفهوم يوحد هذه الثنائيات؟ لا نعرف. ولا يقترح علينا من يعرِّفون الإسلام بهذه الأزواج أي مفهوم موحد ينتظمها. بدل المفهوم يقررون لها اسما: "الإسلام"! وإيديولوجيتهم لا تتهيب من القول صراحة إنه ليس للإسلام نظائر، وأنه مختلف عن كل ما عداه، ومتفوق على كل ما عداه. بيد أن هذا إما حشو لا يفيد شيئا، أو هو تعنت يرفض المفهومية ويفتح الباب للقوة. وهو بالفعل يضع القارئ المتجرد في مناخ من التقريرات المرسلة التي لا تقنع إلا من هو مقتنع بها أصلا. وهو ما يعني أنها قضايا إيمانية، أي تعني المؤمنين بها دون غيرهم. لكن القائلين بها يتطلعون إلى السلطة العليا ليجعلوا منها "دستورا" مفروضا حتى على غير المؤمنين، ممن ولدوا لأبوين مسلمين، وعلى غير المسلمين. والحال، إن الإسلام الذي هو "أوسع وأكبر من كلمة دين" هو شيء غير مفهوم نظريا ونازع نحو القسر والإكراه عمليا. أما الإسلام الذي يمكن أن يقوم على إيمان حي فهو ذاك الذي يجمع بين مخاطبة العقل العام نظريا، و"المفاصلة" جوهريا ونهائيا مع أي إكراه عمليا؛ هو الإسلام كدين، ودين فقط. الإسلام دين، وفي الدين "لا إكراه". أما ما هو "دين ودولة" فإن الإكراه مكون أساسي له، الأمر الذي لا يبذل الإسلاميون المعاصرين جهدا جديا لإنكاره. بل إن اقتران الإسلام بالإكراه والعنف هو سمة العقود الثلاثة الأخيرة في منطقتنا ثم في العالم. حتى ليبدو الإسلام اليوم قوة تمزيق لا قوة توحيد، وطاقة نزاع لا طاقة وئام، ومنبع خوف وقسوة لا مصدر أمن ورفق. وحضور الإكراه في "دين ودولة" هو ما يمهد لرجحان وزن "الدولة" وضمور الدين. أي أن جعل الإسلام دينا ودولة هو باب اضمحلال الدين وتغول الدولة. وهو ما يفتح أبواب حياتنا العامة على التحكم والتربص والعنف. فإذا كنت تتهيأ لفرض نظامك السياسي والحياتي بالقوة، فأية غرابة في أن يجتهد خصومك لمنعك بالقوة، وأين العجيب في أن تغدو القوة والاستبداد بها الحكم بين المتنازعين؟! كما لن تتأخر دولة هي أيضا دين عن إثارة عداء رعاياها، وستسقط سقوطا مستحقا، لكن مكلف وأليم، قبل أن تنتصب مكانها دولة تلعب بالدين مثلها. ولن تكون الدول المتتابعة في مثل هذه الحالة غير "دول" بالمعنى العربي القديم، أي أدوار أو نوبات، تعرف بمن يتولاها، فنقول الدولة الأموية والدولة العباسية ودولة الأيوبيين.. وصولا إلى سورية الأسد وعراق صدام.. ويتولى تصريفَ الدول أو "تداولها" الدهرُ. ومعلوم أن أدوات هذا في التصريف هي الكوارث والحروب والاحتلالات .. من هولاكو إلى بوش. |

|
|
|
#3 |
|
شبه عضو
-- أخ لهلوب --
|
هل يعني رفض كون الإسلام دينا ودولة فصله عن "الحياة والمجتمع" كما لا يكف عن التكرار الشيخ القرضاوي ونظراؤه؟ فوق أنه لا معنى على الإطلاق لفصل الإسلام عن الحياة والمجتمع، فوق أنه لا أحد يستطيعه ولا أحد يدعو إليه، فإن تمييز الدين عن الدولة هو ما يفتح للدين باب التأثير على "الحياة والمجتمع"، والدولة ذاتها، عبر تفضيلات المؤمنين الأحرار ونشاطهم بما هم مواطنون. فالعلمانية التي يندد بها القرضاوي لا تتميز برفض حضور الدين في الحياة العامة، وفي الحياة السياسية ذاتها، بل بالأحرى برفض آلية محددة لحضور الدين، هي تلك التي تسخر الدولة لسياسة الدنيا به. أما حضور الدين الاجتماعي والمدني والثقافي، المنزه عن الإكراه، فينبغي أن يكون أمرا مرحبا به. فهو يمكن أن يكون عنصر إثراء للروح والمخيلة في مجتمعات تهددها الحداثة بجفاف الروح وما بعد الحداثة بالطائفية.
على أن المجال العام الذي يمكن للمؤمنين أن يؤثروا عليه في اتجاه يناسب إيمانهم هو مجال عام ينضبطون فيه بقوانين هي ذاتها التي تضبط غيرهم. ومن البدهي أن القوانين هذه لا يمكن أن تكون "إسلامية" أو مشتقة من "الشريعة". فما يضمن المساواة بين المسلمين وغير المسلمين، لا يمكن أن يكون إسلاميا. إنه بالضرورة قواعد بشرية صنعية، نسبية ومتغيرة. أما ما هو مطلق وثابت، فلا يمكن إلا أن يكون إيمانيا، أي يخص المؤمنين به فقط؛ وحده ما يكون نسبيا، واتفاقيا، ومتغيرا، هو ما يمكن أن يعم الناس. أما الجمع بين ما هو مطلق وعام، إيماني ومفروض على الجميع، فهو باب للطغيان وفساد الدين والدولة معا. وما نريد ترتيبه على ذلك وعلى مجمل هذا التناول هو أن القول إن الإسلام دين ودولة غير معقول، يفرض استقالة إجبارية على عقولنا وعنفا على أجسادنا، قبل أن يكون مضادا للعلمانية أو متعارضا مع الديمقراطية. *** الدولة أيضا مشكلة لأنها بلا شكل ولا نظام، بلا نصاب ذاتي يفرزها عما هو غيرها، من عصبية وثروة وقوة مادية كما قلنا. وهي ليست بلا "دستور" ضابط إلا لأنها بلا شكل، منفلتة وغير مقيدة، منتشرة وطاغية، حتى لو تزودت بالدستور كوثيقة. والدولة المنفلتة، الطاغية، تكتظ بالقوة الخام والاعتباط، فلا تستقل أو تتحكم بنفسها، ولا تشكل أرضية تراكم سياسي مستقل وشخصية متطورة. (هامش توضيحي: نعرف "المشكلة" بأنها وضع بلا شكل أو مشوه الشكل. وهذا "يشكل" على الفهم، ويثير شعورا بالاضطراب والتشوش والعناء العقلي. مصدر "الأشكال" والصور والنظام هو الثقافة. تشوه الأشكال واشتباه الصور يعني أزمة في الثقافة). في مفهومها الحديث، الدولة سلطة عامة سيدة وممأسسة. لا سلطة فوقها في المجتمع المعني، ولا هي تمتلك من قبل فرد أو حزب أو طائفة أو عشيرة. وهي منضبطة بقواعد أو "دستور" ينأيان بها عن مزاج الأفراد وانحيازاتهم الذاتية. الدولة المطابقة لمفهومها ليست طرفا اجتماعيا، وليست جهاز قمع، ولا "أمارة استيلاء"، ولا أداة سلبية تستمد إيجابيتها من عقيدة من يتولاها. إنها مقر العام الاجتماعي وكفالة المساواة بين الأفراد، المواطنين. والأمة التي تنتظم في الدولة غير الأمة الدينية. الأولى أعضاؤها مواطنون، لا تأثير على المساواة بينهم لحيثياتهم الدينية والعرقية واللغوية والجنسية والطبقية وغيرها؛ أما "مواطنو" الثانية فهم المؤمنون وحدهم. بالمناسبة، الإسلام دين و"أمة": دين المسلمين، والمسلمون بما هم مؤمنون به. لكن هذا ينطبق على كل دين آخر. وبالخصوص على اليهودية، حيث هناك "أمة" سياسية واحدة هي ذاتها "الأمة" الدينية. الدولة التي هي في الوقت نفسه حزب وقائد معصوم، الدولة الطرف، سواء كان الطرف إثنية أو جماعة دينية أو مذهبية أو طبقة، تكف عن كونها دولة. ولا مجال لإصلاحها دون فرزها عن هذه التكوينات واستقلالها عنها، وذلك على الصعيدين المفهومي والواقعي. أي أن إصلاح الدولة منوط بأن تحوز قواما خاصا بها أو ذاتية متميزة. بالمثل، لا مجال ولا معنى للإصلاح الديني إن كان الدين هو أيضا دولة وهوية وإيديولوجية سياسية. إننا نفك الدين عن ما علق به مما هو ليس منه، كي نستطيع إصلاحه. هذه عملية مؤلمة وتحتاج صبرا وأناة. لأن ما علق بالدين قد التحم به، إلى حد أن الفصل بينهما قد يقود إلى تحطيم الدين ذاته، وهو ما نفترض أنه مؤلم جدا وغير مرغوب معا. وبالمناسبة، قد يكون أكبر عائق في وجه إصلاح ديني إسلامي هو أن الشروط التاريخية للمسلمين المعاصرين تواطأت مع تفضيلات النخب الإسلامية على جعل "الإسلام" حاملا لهوية جماعية، وفكرة معبئة (إن للاحتجاج والمقاومة أو للتماسك)، فوق كونه دينا يجيب على المطالب الروحية للمؤمنين. ولعل "الإسلام" نجح بالفعل في النهوض بوظائف ليست من مجاله (هوية، تعبئة، إيديولوجية سياسية..)، لكن النجاح هذا بالذات يقف عائقا دون إصلاحه، لأنه يحول دون استقلاله بذاته. لم يثمر الإصلاح الإسلامي عند مطالع القرن العشرين لأنه حين كان محمد عبده "يصلح الإسلام"، كان العالم الإسلامي يدخل في أكبر عملية انقلاب اجتماعي وثقافي وسياسي ونفسي في تاريخه كله، وكان الطلب على الإسلام يرتفع للقيام بعمليات ووظائف نفسية وسياسية ومعرفية، ارتباطها به جائز ليس إلا. بعبارة أخرى، حين كان ينبغي تحريك الإسلام وإعادة بنائه حول الإيمان، كان المسلمون مقلقلون نفسيا، يتآكلهم الجزع ويعصف بهم الدوار، يطلبون تثبيت العالم حولهم لأنهم كانوا عاجزين عن الثبات في العالم. "الإسلام" هو ما سيلبي مطلب التثبيت. لكن الثمن هو توسعه ليغدو، لأول مرة، دينا ودنيا، ومصحفا وسيفا..إلخ. أي ليعيد اختراع عالمه، وينتصب فيه سلطانا كليا. هذا يعني أن على أي إصلاح ديني إسلامي جدير باسمه أن يصدر عن إدراك تاريخي شامل لهذه الشروط التاريخية (وهو ما لا يستطيع تقديمه الإسلاميون العالقون في شباك أمثلة الماضي والاغتراب عن الحاضر)، وأن يعمل على تخليص "الإسلام" من وظائف وتوظيفات ارتبطت به لأسباب تاريخية جائزة دون أن تنبثق منها انبثاقا ضروريا كدين. واليوم، يبدو أن نهج توكيل الإسلام بعملية تثبيت العالم من حولنا لا تثبت العالم ولا تنصر الإسلام. آن الوقت لنهج مختلف، نثبت أنفسنا في العالم، وهو ما من شأن الإيمان الإسلامي، أي التوحيد والعدل والرحمة، أن يساعد فيه بلا ريب. *** هذه قضايا لا تبدو إشكاليتا العلمانية والديمقراطية الرائجتان مهيئتين لمقاربتها، نظريا أو عمليا. وإخفاقهما هذا يردهما إلى إيديولوجيتين. على أنه ينبغي تمييز هذا القول عن أقوال تبدو مشابهة. ليست العلمانية إيديولوجية لأنه لا سلطة دينية في الإسلام (ثمة سلطة دينية في الإسلام، وإنكارها هو الإيديولوجية)، بل لأن وضع الإسلام مختلط وغير منظم، ولأن العلمانية تغطي على المشكلة الدينية ولا تقدم حلا لها. الواقع أنها تبدو معنية إما بتهميش الدين أو بفصله جهازيا وقسريا عن المجال العام، الأمر الذي لا يشكل أبدا خطوة على طريق استقلاله، إن لم نقل العكس. ما يكاد يقوله أكثر علمانيينا هو أن الدين هو المشكلة. هذا ينطبق بصورة خاصة على من وردوا بئر العلمانية من جهة العلم لا من جهة الدنيا والعالم أو السياسة والدولة. أعني من يناهضون الدين كاعتقاد لا الدين كتطلع للسيطرة السياسية. والموقف هذا غير سليم نظريا، وغير مفيد عمليا. لدينا مشكلة دينية، لكن ليس وجود الدين هو المشكلة (هل من حل غير فاشي إن اعتبرنا الدين هو المشكلة؟). بل يمكن للدين أن يكون جزءا من الحل. بيد أن دون ذلك إعادة تأسيس الدين كنصاب مستقل، قائم على الإيمان ونفي الإكراه. يختلف هذا المنظور عن العلمانية الرائجة بأنه يؤسس الفصل بين الدين والدولة على دفاع عن ذاتية الدين واستقلاله وتكامله الذاتي، كما عن ذاتية الدولة واستقلالها وتكاملها. هذا شأن لا يتبينه حتى علمانيون غير معادين للدين ولا يعتبرونه هو المشكلة. يريد هؤلاء أن ينفصل الدين عن الدولة، ثم فليفعل بنفسه ما يشاء. لكن الدين الذي لا نهتم بمصيره، المتروك لشأنه، يمكن أن يتعلق برقبة الدول والمجتمعات ويخنقها. هذا يحصل الآن. وهو ما يعني أن الدين وتنظيمه وموقعه في الحياة العامة، وليس فقط فصله عن الدولة، هو ما ينبغي أن نهتم به كمثقفين وناشطين عامين. فلا نظنّن أنه يمكن أن ندخل العصر مع ترك الدين الذي رافقنا قرونا طويلة على بواباته. إن الإصلاح الديني، أي إعادة هيكلة الدين حول الإيمان ونفي الإكراه، وليس العلمانية، هو الإشكالية التي تستوعب هذه المسائل. وبقدر ما أن استتباع الدين سياسيا وفساد الإيمان وجهان للواقع الحالي، فإن الإصلاح الديني واستقلال الدين وجهان للعملية التاريخية التي قد تقود إلى تثبيتنا في عالم لا يكف عن الانقلاب. |

|
|
|
#4 |
|
شبه عضو
-- أخ لهلوب --
|
إن العلاقة بين الدين ولا إكراه علاقة ضرورية، حتى لو لم يقررها القرآن. وأن يكون القرآن قرر ذلك بعبارة صريحة، أمر يسهل إصلاح الدين لو كان يحدونا الرشد، لو كنا ننحاز للمعقول المفتوح لا للهوية المغلقة، وللإيمان لا للسلطة. الإكراه، لا بأس بتكرار، هو باب اللادين، الدولة أو ما شئت. و"لا إكراه"، تكرارا أيضا، هو المضمون الجوهري للإصلاح الديني الإسلامي. أو إن هذا يتمثل في طرد الإكراه، بمعنييه العقلي (تقريرات تعسفية) والجسدي (عنف..)، خارج الدين (مع العمل على أن حصر الإكراه الجسدي بيد الدولة). فحيث الدين لا إكراه، وحيث الإكراه لا دين. في الإسلام دولة؟ نعم. لكن الدولة هذه ليست في دين الإسلام، بل في دنيا المسلمين. والفصل التحليلي والعملي بين دول إسلام محتملة (= دول أكثر سكانها مسلمون) وبين دين الإسلام ضرورة عقلية ودينية وسياسية معا. فالدين ثابت والدولة متغيرة، وهي تنضبط بقواعد المصلحة والحكمة البشرية ومقتضيات التاريخ والأوضاع الدولية الدنيوية. وهي لا تستطيع أن تزامن عصرها دون أن تنفصل عن الدين، أما هذا فيفقد ماهيته الإيمانية إن اندرج في الزمانية (ما يفقد البشر رصيدا متعاليا على التاريخ لا غنى لهم عنه في الشدائد، والشدائد جوهرية في التاريخ والمصير البشري). "وصل" الدين والدولة يعني خلط المتعالي والدنيوي، والأبدي بالزمني، والهداية بالإكراه. وهذا فساد لهما معا.
ويتراءى لنا أن الإصلاح الديني الإسلامي، بهذا المعنى، يقتضي قيام مؤسسة دينية إسلامية مستقلة، تضع حدا للتبعثر الديني، وتضمن للمسلمين مرجعية تنظم حياتهم الدينية، وتخفف الضغط على الدولة من أجل تنظيم شؤونهم. بل ونحدس أن استقلال الدين عن الدولة يقتضي استقلاله بأمره، أي سيادته في مجاله وقيام سلطة تدير شؤون الإيمان وشرائطه العبادية والسلوكية والاجتماعية، وتشرف على الشؤون الدينية للمؤمنين. أي أن قيام سلطة دينية موحدة ومستقلة هو استخلاص منطقي من استقلال الدين عن سلطة الدولة. هذا بينما نلاحظ اليوم أن استتباع الدين سياسيا، أي إلغاء استقلاله عن الدولة، يقود إلى تبعثره كدين وفقدانه للنواة الصلبة الحية التي تماسك حولها، أي زوال استقلاله بنصاب يخصه. ثم إن قيام سلطة دينية مستقلة هو ما يمنع في آن إعادة استتباعه ويقف في وجه مطامحه السلطوية السياسية. بكلمات أخرى، تبدو لنا العلاقة بين الفصل بين الدين والدولة وبين تكون سلطة دينية مستقلة علاقة اقتضاء متبادل. لا هذه، إذن لا تلك، والعكس بالعكس. ومن شأن انفصال الدين عن الدولة، إن لم يترافق لسبب ما (فصل قسري مثلا) مع تكون قوام ديني متماسك ومستقل، أن يبقي هذا الانفصال عكوسا، وأن تبقى الثقافة "اتصالية". ونتصور كذلك أن من شأن تكون سلطة دينية مستقلة أن يشجع انفصال الدين عن الدولة. أي أننا نتصور أن العلمنة في الإسلام الشيعي أسهل منها في الإسلام السني بسبب وجود ما يقارب سلطة دينية مستقلة في الأول. *** لكن كيف ستقوم هذه السلطة الدينية؟ ومن سيعمل على قيامها؟ وأين؟ في النطاقات الوطنية القائمة أم في العالم الإسلامي ككل؟ السني والشيعي؟ أسئلة مهمة، لكنها ليست ضرورية في هذه المناقشة. ندلي هنا بثلاث ملحوظات تتصل ضرورة قيام سلطة/ سلطات دينية في بلداننا (ننحاز مبدئيا إلى انحصار هذه السلطات في الأطر الوطنية القائمة): (1) لا نرى ما يمنع ذلك إسلاميا. كان النجاح الدنيوي السريع لـ"الإسلام" قد أغناه عن تطوير مؤسسة دينية مستقلة. لكنه بالمقابل حول مركز ثقله إلى الدنيا، وفي قلب هذه "الدولة"، التي كانت تعني "دورا" لاعتلاء الدنيا ("لجلب الدنيا إلى الرؤساء" في عبارة أبي العلاء)، في دهر قُلَّب لا أمان له ولا دوام فيه. فرز الإسلام عن الدولة من شأنه أن "يضطره" إلى إقامة سلطة أو مؤسسة دينية مستقلة. (2) هذا جيد أيضا لمجتمعاتنا، قد يساعدها قيام مرجعية دينية مستقلة على أن تغدو مجتمعات فيها سلطتان وحصانتان، فتغدو مجتمعات ثنائية القطب، أي أكثر توازنا، وأكثر تماسكا وممانعة للسقوط إن انهارت النظم الحاكمة؛ أقبل من ثم للدمقرطة. (3) وهذا ليس ممتنعا تاريخيا أيضا. تغيرت المسيحية بعد أن انقضى من عمرها أمدا يزيد على عمر الإسلام حتى يومنا. متكلما على العلمانيين، يقول الشيخ القرضاوي: "يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنية، وهو ليس فيه سلطة دينية، كالمسيحية، فمعناه: أن يبقى ضعيفا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين". المشكلة حقيقة. وقيام سلطة دينية إسلامية قد يكون جوهر الحل. *** قلنا إن سبب كون العلمانية إيديولوجية في ديارنا ليس غياب سلطة دينية، بل هو عدم تبين اشتباه أو اختلاط الدين كقاعدة لهذه السلطة، وكذلك الغفلة عن واقع استتباعه من قبل سلطات الدول. كذلك ليست الديمقراطية إيديولوجية لأن الدولة في بلادنا ليست مستبدة، بل لأنها ليست دولة. إنها سلطة خاصة (ضد عامة)، مزاجية (ضد مؤسسية)، جهازية أو أداتية (بلا شخصية ذاتية، وضد "أخلاقية" بالمعنى الهيغلي للكلمة). هذا ما تشوشه الفكرة الديمقراطية الرائجة بميلها إلى رؤية سلطة الدولة من منظور تقليصها لا من منظور ضبطها. من جهتنا، نميل إلى أن الديمقراطية تقتضي مزيدا من السلطة في تصرف الدولة لا العكس. ديمقراطية في ظل الندرة السلطوية هي باب للفوضى أو الانقلابات. نميل كذلك إلى أن الدول لدينا عنيفة ووحشية لأن سلطتها هزيلة وغير مستبطنة. في المدرسة والشارع ، في المشفى الحكومي وحتى في دوائر الدولة، في كل مكان خارج البيوت، السلطة واهنة أو حتى غير موجودة. الدولة تظهر كثيرا كقسر، أي كسلطة محض، لأنها غائبة كانضباط وقانون. إصلاح الدولة يقتضي تطوير آليات الانضباط الذاتي وحكم القانون. هذا بدوره يقتضي تطوير البعد الأخلاقي للدولة. ما يشترط بالضرورة استقلال الدولة واستبطانها للمبدأ الأخلاقي (المساواة والحرية)، الأمر الذي لا توفره الدولة الدينية (والعقيدية، حتى لو كانت عقيدتها ضد الدين) لأن مبدأها خارج عنها، ولأنها دولة أداتية فحسب. استقلال الدولة بالسلطة العامة، إذن، لا يقتضي التقليل من سلطتها، بل بالعكس زيادتها وشمولها كل حيزات المجتمع، وإن كان شكلها يتغير من القمعي البراني إلى الانضباطي الجواني. إن الدولة الديمقراطية هي "دولة شمولية"، تحترم حرية الأفراد واستقلالهم السياسي. وبهذا المعنى الوفرة السلطوية شرط للديمقراطية ولاستقلال الدولة، بمعنيي كلمة استقلال: استقلالها عن غيرها، واستقلالها بـ"مادة" خاصة بها، السلطة العامة. ولعل استقلالها بمادتها يشرط استقلالها عن غيرها، كما أن استقلال ما هو ديني يشرط قيام سلطة دينية مستقلة، وهما معا يشرطان استقلال الدين عن الدولة. *** وزبدة القول إن استقلال الدين وتمحوره حول الإيمان واللاإكراه هو أساس حل مشكلتنا الدينية التي تزداد تعقيدا. وهو ما سيقتضي قيام مراكز دينية إسلامية مستقلة. العلمانية تكاد تغدو هنا تحصيل حاصل. وإن كان للدعوة العلمانية أن تسهم في مقاربة المشكلات العربية اليوم، فربما من خلال تقوية شخصية الدين لا العمل على إضعافها. كما أن قيام الدولة كمركز لتراكم السلطة ومقر للعمومية الاجتماعية هو أساس حل مشكلتنا السياسية. وهنا الديمقراطية تغدو أسهل نسبيا. إذ أن توزيع السلطة الوفيرة عكس توزيع السلطة الشحيحة، أمر ممكن. في الختام، هذه المقالة جهد أولي من أجل تنظيم التفكير في شأن الدين والدولة والعلاقة بينهما. وهو جهد يعاني من فجوات كثيرة، إن على مستوى التحليل الأساسي وضبط المفاهيم، أو على مستوى إغناء التحليل بمعلومات وأمثلة وتفصيلات وشواهد ربما تعززه، أو تعدله. الأرضية الواقعية لهذه المقاربة هي سورية عام 2007، لكننا نظن أنه الإصلاح الديني والسياسي، العلمانية والديمقراطية، كلها غير ممكنة في بلد واحد. إنها قضايا عربية، وإسلامية. يبقى أنه سيلزم الكثير من اجتهاد العقل والقلب لتطوير مقاربة أنضج. المهم ألا نجزع، وألا نستعجل، وألا نيأس. "الرأي / خاص" |

|
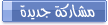
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 17:19 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)




