
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | بحبشة و نكوشة | مواضيع اليوم | أشرلي عالشغلات يلي قريانينها |
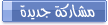
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 | ||||||
|
مشرف
|
أدب الشغّالات حتمـاً، ثـمَّـة سرٌّ ما. ذلك أني ما أحضرت شغّالة، من أيّ جنسية كانت، إلاّ وبدت عليها أعراض الكتابة، بدءاً بتلك الفتاة المغربية القروية، التي كانت تقيم عندي في باريس، لتساعدني على تربية الأولاد، فوجدتُ نفسي أُساعدها على كتابة رسائل حبّ لحبيبها. ومن أجل عيون الحبّ، لا من أجل عينيها، كنت أُنفق كثيراً من وقتي لأجعل منها فتاة "شاعرة" ومُشتهاة، حتى انتهى بي الأمر، إلى العمل "زنجيّة" لديها، بكتابة رسائل حبّ لحبيبها نيابة عنها! خديجــة، التي كنت "زنجيتها"، حسب التعبير الفرنسي، والكاتبة التي تختفي خلف أحاسيسها وقلمها، كانت في الواقع فأرتي البيضاء، ومختبراً لتأمُّلاتي الروائية. أُمِّـي كانت تحلف بأغلظ الأَيمَان بأنّ الفتاة سَحَرَتني، حتى إنني منحتها أجمل ثيابي، وكنت أعيرها مصوغاتي وحقائب يدي لمواعيدها العشقية، وأبذل من الجهد والعناء في تحويلها من فتاة كانت قبلي تغسل ثيابها على ضفاف النهر، إلى فتاة من هذا العصر، أكثر مما كانت تُنفق هي من وقت في الاهتمام بأَولادي. ذلك أنَّ البنت ذات الضفائر البدائية الغليظة، ظهرت عليها مع عوارض حُـبٍّ باريسي لشاب سوري، أعراض الكتابة الوجدانية في سذاجة تدفُّقها الأوّل. وأخشى إنْ اعترفت بأنني كنت أيام إقامتها عندي أكتب "ذاكــرة الجســد"، أن يستند أحدهم إلى مقالي هذا، مُلمِّحاً إلى احتمال أن تكون شغّالتي مَن كَتَبَت تلك الرواية، نظراً إلى كونها الوحيدة التي لم تنسب إليها الرواية حتى الآن. عندما انتقلت إلى بيــــــروت، بَعَثَ لي اللَّــه، سيِّـدة طيِّبة وجميلة، من عمري تقريباً، جَمَعَت، على الرغم من مظهرها الجميل، إلى مُصيبة الفقــر، لعنة انقطاعها باكراً عن التعلُّم. لـــــذا، ما جالستها إلاّ وتنهَّدت قائلــة: "كم أتمنَّى لو كنت كاتبة لأَكتُب قصَّتي". وراحـــت تقصُّ علـيَّ مآسيها، عساني أستفيد منها روائياً، وربما سينمائياً، نظراً إلى ما تزخر به حياتها من مُفاجآت ومُفاجعات مكسيكية. ماري، التي كانت تَجمَع كل ما فاض به بيتي من مجلات، وواظبت على القراءة النسائية بفضلي، مازالت منذ سنوات عـدَّة تتردَّد علـيَّ في المناسبات، ولا تُفوِّت عيــداً للحُبِّ إلاَّ وتأتيني بهدية. في آخر عيــد للحب أهدتني دفتـراً ورديـاً جميلاً لكتابة المذكرات، مرفوقاً بقلم له غطاء على شكل قلب، وكتبت على صفحته الأُولى كلمات مؤثِّـرة، بشَّـرنـي زوجي عند اطِّلاعه عليها بميلاد كاتبة جديدة! جاءت "روبــا"، وهو اسم شغّالتي السريلانكية التي عرف البيت على أيامها، العصر الذهبي لكتابة الرسائل واليوميات. فقد استهلكت تلك المخلوقة من الأوراق والأقلام، أكثر ممّا استهلكنا عائلياً جميعنا، كتّابـاً وصحافيين.. وتلاميذ. وكنت كلَّما فردت أوراقي وجرائدي على طاولة السفرة، جاءت "روبـــا" بأوراقها وجلست مقابلة لي تكتب(!)، وكان أولادي يَعجبون من وقاحتها، ويتذمّرون من صبري عليها، بينما كنت، على انزعاجي، أجد الْمَشهد جميلاً في طرافته. ففي بيت عجيب كبيتنا، بدل أن تتعلَّم الشغّالة من سيدة البيت طريقة "حفر الكوسة" و"لف الملفوف" وإعداد "الفتُّوش"، تلتحق بـ"ورشة الكتابة" وتجلس بجوار سيِّدتها، مُنهمكة بدورها في خربشة الأوراق. وعلى الرغم من جهل زوجي للغة "الأوردو" و"السنسكريتية"، فقد كان أوّل مَن باركَ موهبة الشغّالة، واعترف بنبوغها الأدبي، إلى حدِّ تساهله معها في ما لا تقوم به من شؤون البيت، بحُكم وجودها معنا، على ما يبدو، لإنجاز كتابها، واعتبار بيتنا فندقاً للكتابة من تلك الفنادق التي تستضيف الكُتّاب على حساب مؤسسات لإنجاز أعمالهم الأدبيّة. حتى إنه أصبح يناديها "كوماري"، على اسم الكاتبة السريلانكية الشهيرة "كوماري جوديتا"، التي كانت آنــذاك مُرشَّحة لرئاسة "اليونسكو"، وراح يُحذِّرني مازحـــاً من أن تكون البنت مُنهمكة في كتابة مُذكّراتها عندنا، وقد تفشي بكثير من أسراري، وتصدر كتابها قبل كتابي، وقد تصرُّ على توقيعه في معرض بيروت للكتاب، أُسوة بالشغّالة السريلانكية التي تعمل عند الفنان الراحل عارف الريس، التي كانت تقوم نهاراً بأشغال البيت، وترسم سرّاً في الليل، مستفيدة من المواد المتوافرة في مرسم سيِّدها. و كانت عَظَمَة عـــــارف الريس، في تبنِّي موهبة شغّالته، بدل مُقَاصصتها بدل سرقة بعض أدواته، بل ذهب إلى حدِّ إقامة معرض فني لها، تـمَّ افتتاحه برعاية سفير سريلانكا في لبنان. ولو أنّ أُمِّـي سمعت بتهديدات زوجي لي، بأن تسبقني الشغّالة بإنجاز كتابها، لردَّدت مَثَلَها الجزائري الْمُفضّل "العود اللي تحقــرُو هـــو اللّــي يعميــك". وهو ما كان يعتقده إبراهيــم الكونــي، حين قال "خُلق الْخَدَم ليثأروا منَّا، لا ليخدمونا". أمَّـا مناسبة هذا الحديــث، فعودة ظهور الأعراض إيّاها، على شغّالتي الإثيوبية، التي لا تكتفي بتقليد ملابسي وثيابي، ومُتابعة نظام حميتي، واستعمال كريماتي، بل وتأخذ من غرفتي أوراقي وأقلامي، وتختفي في غرفتها ساعات طويلة، لتكتب. أخشى أن تكون مُنهمكة في كتابة: "الأَسوَد يَليق بكِ
انك " فقير إلى الآخر " كما هو فقير إليك " وأنك محتاج إلى الآخر ، كما هو محتاج إليك
الأب جورج
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
|
||||||

|
|
|
#2 | ||||||
|
مشرف
|
أطلق لها اللحى لو لم تكن الصورة تحمل أسفلها خبراً عاجلاً، يعلن وقوعه في قبضة “قوات التحرير”، ما كنا لنصدِّق المشهد. أيكــون هــو؟ القائد الزعيم الحاكم الأوحد، المتعنتر الْمُتجبِّـر، صاحب التماثيل التي لا تُحصى، والصور التي لا تُعدّ، وصاحب تلك القصيدة ذات المطلع الذي غدا شهيراً، يوم ظهر على الشاشة عند بدء الحرب الأميركية على العراق، مطالباً بوش بمنازلته. أيكون صاحب “أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل”، قد “أطلق لها اللحية”، بعد أن خانه السيف وخذله الرفاق، ولم يشهد له زُحل سوى بالحمق والجريمة؟ أكان هو؟ ذلك العجوز مُتعــب الملامح، المذعور كذئب جريح، فاجأه الضوء في قبو، هو بشعره المنكوش ولحيته المسترسلة، هو ما عداه، يفتح فكّيه مستسلماً كخروف ليفحص جندي أميركي فمه. فمه الذي ما كان يفتحه طوال ثلاثين سنة، إلاّ ليعطي أمراً بإرسال الأبرياء إلى الموت، فبين فكّيه انتهت حيوات ثلاثة ملايين عراقي. أكانت حقاً تلك صورته؟ هو الذي ظلّ أكثر من ثلاثة عقود، يوزع على العالم سيلاً من صوره الشهيرة تلك، في أزيائه الاستعراضية الكثيرة، وسيماً كما ينبغي لطاغية أن يكون، أنيقاً دائماً في بدلاته متقاطعة الأزرار، ممسكاً ببندقية أو بسيجار، مبتهجاً كما لو أنه ذاهب صوب عرس ما. فقد كان السيد القائد يُزفّ كل يوم لملايين العراقيين، الذين اختاروه في أحد تلك الاستفتاءات العربية الخرافية، استفتاءات “المئة في المئة” التي لا يتغيّب عنها المرضى ولا الموتى ولا المساجين ولا المجانين ولا الفارُّون، ولا حتى المكوّمون رفاتاً في المقابر الجماعيّة. وكان الرجل مقتنعاً قناعة شاوشيسكو، يوم اقتيد ليُنفّذ فيه حكم الشعب، هو وزوجته، رمياً بالرصاص، إنه “معبود الجماهير”، هو الذي بدأ حياته مُصلِّح أحذية قبل أن يصبح حاكماً، وتبدو عليه أعراض الكتابة والتنظير. وبالمناسبة، آخر كتاب كتبه السيد القائد، كان رواية لم يتمكّن من نشرها، وهي تتمة لـ”زبيبة والملك”. وكان عنوانها “اخرج منها أيها الملعون”. ولا يبدو أنها أفادته في تدبُّـر أمره والخروج من الكارثة التي وضع نفسه فيها، مُورِّطاً معه الأُمّـة العربية جمعاء. فرصته الوحيدة، كانت في النصيحة التي قدّمها إليه الشيخ زايد، بحكمته الرشيدة، حين أشار عليه بالاستقالة تفادياً لمزيد من الضحايا والأضرار، التي ستحلّ بالعراق والأُمة العربية. وأذكر أن وزير خارجيته أجاب آنذاك في تصريح خالٍ من روح الدعابة “الرئيس صدام حسين لا يستطيع اتخاذ قرار بالتخلي عن ملايين العراقيين الذين انتخبوه بقناعة ونزاهة”. في هذه الأُمّـة التي لا ينقصها حُكّام بل حُكماء، كانت الكارثة متوقعة، حتى لكأنها مقصودة. وبعد أن كان العميل المثالي، أصبح صدّام العدو المثالي لأميركا، وعلى مرأى من أُمّة، ما كانت من السذاجة لتحلم بالانتصار على أميركا، ولكن كانت من الكرامة بحيث لن تقبل إلاّ بهزيمة منتصبة القامة تحفظ ماء وجهها. “حملة النظافة” ستستمر طويلاً، في هذه الحرب، التي تقول أميركا إنّ أهدافها أخلاقية. ومهما يكن، لا نملك إلاّ أن نستورد مساحيق الغسيل ومواد التنظيف من السادة نظيفي الأكفّ في البيت ناصع البياض في واشنطن. من بعض فجائع هذه الأُمة، فقدان حكامها الحياء. إنه مشهد الإذلال الأبشع من الموت. ومن مذلّة الحمار... صنع الحصان مجده. |
||||||

|
|
|
#3 | ||||||
|
مشرف
|
أن أكون في كلِّ التراويح.. روحَك ما طلبتُ من اللّهِ في ليلةِ القدر سوى أن تكون قَدَري وستري سقفي وجُدران عُمري وحلالي ساعةَ الحشرِ ** يا وسيمَ التُّقَى أَتَّقي بالصلاةِ حُسنكْ وبالدعاءِ ألتمسُ قُربكْ أُلامسُ بالسجودِ سجاداً عليه ركعتَ طويلاً عساني أُوافق وجهك ** مباركةٌ قدماك بكَ تتباهَى المساجد وبقامتك تستوي الصفوف هناك في غربة الإيمان حيثُ على حذر يُرفع الأذان ** ما أسعدني بك مُتربِّعاً على عرش البهاء مُترفِّعاً.. مُتمنعاً عصيَّ الانحناء مُقبلاً على الحبّ كناسك كأنّ مهري صلاتُك ** يا لكثرتكْ كازدحام المؤمن بالذكرِ في شهر الصيام مزدحماً قلبي بكْ ** كيف لــي أن أكون في كلّ التراويح روحَكْ كي في قيامك وسجودك تدعُو ألاَّ أكون لغيرك |
||||||

|
|
|
#4 | ||||||
|
مشرف
|
أقلام للقلب.. وأُخرى للجيب نسيت أن أقول لكم، إنني كتبت مقالي السابق عن الجزائر، بقلم طُبع عليه بالفرنسية عبارة “بوتفليقة في قلبي”· فقد طاردتني الحملة الانتخابية حتى الطائرة العائدة بي من الجزائر إلى بيروت، ولم أجد وأنا محجوزة مدة أربع ساعات، سوى قلم أهداني إيّــاه أحد أنصار بوتفليقة، عندما زرت صديقتي خالدة مسعودي، وزيرة الثقافة والاتصال، في زيارة ودِّية لرفع العتب قبل مغادرتي الجزائر بيوم· خالدة الرائعة، والمناضلة الشهيرة بتاريخ تصدِّيها للمتطرفين، الذين أحلُّوا دمها، وأرغموها لسنوات على الدخول في الحياة السرية، هي بثقافتها وشجاعتها السياسية، الفرس البربري الجامح، الذي راهن عليه بوتفليقة لكسب ثقة اليساريين والبربر والنساء بورقة واحدة· إنها، بأصالتها وبساطتها، لا تشبه إلا نفسها·· بشعرها الأشقر الرجالي القصير، وبملامح أُنثوية جميلة، وبتلقائية وحماسة تفتقدهما عادة النساء حال جلوسهن على كرسي رسمي· فهي لا ترتدي تاييراً سوى في المناسبات· وتفعل ذلك بأناقة أوروبية “عمليّة” من دون بهرجة أو تشاوف· لا يزعجها أن تكون كفّاها مُطرّزتين بالحناء في كل مناسبة دينية، وبهما تكتب مرافعاتها ومحاضراتها السياسية، التي تُمثل بها الجزائر بتفوق في المحافل الدولية، بلغة فرنسية راقية، ما عاد يتقنها الفرنسيون أنفسهم· لكنها، مذ شغلت مناصب سياسية كثيرة، أحدها ناطقة باسم الحكومة، رفعت خالدة تحدِّي اللغة العربية، وأصبحت تتحدث الفصحى بطلاقة· مدير مكتبها قال لي مازحاً وهي ترغمني بمودَّة على مُرافقتها إلى قصر الثقافة لتدشين معرض “جمعية الأمل لترقية وحماية المرأة والطفولة”: “إنها امرأة دائمة الركض·· أكثر عدوَاً من العدّاءة حسيبة بومرقة” (الجزائرية حائزة الميدالية الذهبية في العدوِ)· أتركها تسبقني بخطوات مُراعاة لمنصبها، لكنها تعود وتبحث عني لتُقدمني بفخر لنساء أنصاف أُميّات، يستقبلنها بالزغاريد، ويأخذن معنا صوراً تذكارية·· هـنّ البائسات اللائي فقدن بيوتهن في الزلازل، واللائي أوجدت لهن جمعيات وتظاهرات تمكّنهن من بيع منتجاتهن اليدوية وإعالة عائلاتهن· تضمّهن واحدة واحدة·· تقبّلهن بمودَّة وصبر· توشوشني: “لابد من دعمهن· العمل أشرف لهن من مدّ أيديهن إلى الدولة أو إلى أزواجهن”· عدنا مُحمَّلتين بالورود، وبهدايا رفضتُ بمحبّة معظمها مُراعاة لحاجة مُقدِّماتها· لكنني احتفظت بالأقلام، ونسيت أن أعطيها أُمي التي كانت سعيدة بأن تعيش أوّل حملة انتخابية على الطريقة الأميركية· فراحت تجمع كل ما لهُ علاقة بمرشحها المفضّل بوتفليقة، من قمصان وقبّعات وشارات، تقوم بتوزيعها بدورها على السائق، وأبناء أخي ومَن يزورنا من شغِّيلة· وأنا أكتب في الطائرة مقالي بذلك القلم الذي عليه عبارة “بوتفليقة في قلبي”، تذكّرت الدكتور غازي القصيبي الذي قال لي مرّة “إنّ مَن يهدي كاتباً قلم حبر كمن يهدي فرّاناً ربطة خبز”· وكنت يومها أشكو إليه إصرار بعض قارئاتي الثريات، على إهدائي أقلاماً فاخرة، يعادل ثمن بعضها تكاليف طباعة كتاب، من دون أن تكون تلك الأقلام قادرة على إلهامك نصّاً جميلاً، لكونها في حلّتها الذهبيّة تلك، لم تُخلَق سوى لتوقيع الصفقات والشيكات، ما جعلني أحتفظ بها في درج خاص لمجرّد الذكرى، لكوني لا أعرف الكتابة سوى بأقلام التلوين المدرسيّة التي تُباع في علبة من اثني عشر قلماً، لا أستعمل منها سوى أربعة ألوان· ونظراً إلى سعرها الذي لا يتجاوز الثلاثة دولارات، فأنا أُلقي ببقية الأقلام في سلَّة المهملات· وبالمناسبة، أجمل قلم أحتفظ به أهداني إيّــاه الدكتور غـــازي القصيبي، في التفاتة جميلة من كاتب يدري أن القلم المستعمل، ذا “السوابق الأدبيّة”، أثمن من أقلام “بِكْر” لم تقترن بيد كاتب، وأن إهداء كاتب كاتباً آخر قلمه الشخصيّ هو أعلى درجات المودّة والاعتراف بـ”قلم” الآخر· لكن المحرج بالنسبة إلى كاتب، أن يكتب بقلم طُبع عليه اسم رئيس، حتى وإن كان ذلك الرئيس صديقاً منذ ثلاثين سنة، ومكانه في القلب حقّــاً· |
||||||

|
|
|
#5 | ||||||
|
مشرف
|
بطاقات معايدة.. إليك
- غيرة أغــار من الأشياء التي يصنع حضوركَ عيدها كلّ يوم لأنها على بساطتها تملك حقّ مُقاربتك وعلى قرابتي بك لا أملك سوى حقّ اشتياقك ما نفع عيد.. لا ينفضح فيه الحبُّ بكَ؟ أخاف وشاية فتنتك بجبن أُنثى لن أُعايدك أُفضّل مكر الاحتفاء بأشيائك ككل عيد سأكتفي بمعايدة مكتبك.. مقعد سيارتك طاولة سفرتك مناشف حمّامك شفرة حلاقتك شراشف نومك أريكة صالونك منفضة تركت عليها رماد غليونك ربطة عنق خلعتها لتوّك قميص معلّق على مشجب تردّدك صابونة مازالت عليها رغوة استحمامك فنجان ارتشفت فيه قهوتك الصباحيّة جرائد مثنية صفحاتها.. حسب اهتمامك ثياب رياضية علِق بها عرقك حذاء انتعلته منذ ثلاث سنوات لعشائنا الأوّل.. طلب لا أتوقّع منك بطاقة مثلك لا يكتب لي.. بل يكتبني ابعث لي إذن عباءتك لتعايدني عنك.. ابعث لي صوتك.. خبث ابتسامتك مكيدة رائحتك.. لتنوب عنك. - بهجة الآخرين انتهى العام مرتين الثانية.. لأنك لن تحضر ناب عنك حزن يُبالغ في الفرح غياب يُزايد ضوءاً على الحاضرين كلّ نهاية سنة يعقد الفرح قرانه على الشتاء يختبرني العيد بغيابك أمازلت داخلي تنهطل كلّما لحظة ميلاد السنة تراشق عشّاق العالم بالأوراق الملوّنة.. والقُبل وانشغلت شفتاك عني بالْمُجاملات.. لمرّة تعال.. تفادياً لآثام نِفاق آخر ليلة.. في السنة! |
||||||

|
|
|
#6 | ||||||
|
مشرف
|
أَكلّ هَذَا الدَّم.. لإسكات قَلَم؟ أعذر مَن لم يسمع منكم بسمير قصير قبل الخبر الْمُدوِّي لموته. فسمير ما كان نجم الشاشات، ولا ديك الفضائيات. لم يُشارك في مسابقة للغناء، لم يصل بعد حملة (sms) إلى التصفيات النهائية في “ستار أكاديمي”. كان أكاديمياً مُتعدِّد الهواجس والثقافات. كان أستاذاً جامعياً يُحرِّض الأجيال الناشئة على الانتماء إلى حزب الحقيقة. لذا، أزعجتهم حِبَالُــه الصوتيّة. لم يحاول أن يكون يوماً “سوبر ستار” العرب. هو الفلسطينيُّ الأب، السوري الأُم، اللبنانيّ الْمَذهَب والقلب، ما كان ليدخل منافسة تلفزيونيّة تحت رايــة واحدة، فلم يؤمن بغير العُروبـــة علماً وقَدَراً. لـــــذا، لم يترصّد أخباره المعجبون، بل المخبرون، ولم تتدافع الْمُراهقات للاقتراب منه وأخذ صور له حيثما حلَّ، بل كانت أجهزة الأمن تتكفّل بكلّ ذلك. الفتى العربي الْمُتَّقد الذكاء، الذاهب عُمقاً في فهم التاريخ، ما كان حنجرة، كان ضميراً. لــــذا، لم يقف أمام لجنة تحكم على صوتــه، بل كان يدري منذ البدء أنّ رجالاً في الظَّلام يحاكمونه كظاهرة صوتيّة في زمن الهمس والهمهمات. الفتى العربي الوسيم، النقيّ، النبيل، المستقيم، في كل ما كتب، ما كان حبره الذي يسيل، بل دمه. اعتاد أن يرفع صوته على نحو لا رجعة عنه، على الرغم من علمه أنّ للصوت العالي عندما يرتفع خارج الطبقات الصوتيّة للطرب ثمناً باهظاً. ففي حوار المسدّس والقلم، المقالات الناريّة يردُّ عليها بالنار. كان عليك أن تُغنِّي يا صديقي.. فتَغنَى، وتستغني عمّا عرفت من ذُعر الكاتب الْمُطارَد، أن تكون هدفاً إعلامياً بدل أن تغدو رجلاً مُستهدَفاً، أن تستخدم وسامتكَ في طلّة إعلانيّة لبيع رغـــوة للحلاقة، أو الترويج لعطر جديد، بدل استخدام أدواتك الثقافية والْمَعرفيّة لِمُقارعــة القَتَلَــة. تأخَّــر الوقت لأقنعك ألاَّ تبصم بدمك على كلّ ما تكتب، فتسقط مُضرجاً بحبرك. يا هذا الحصان الجَامح لا حصانة لك. الكاتب كائن أعزل لا يحتمي سوى بقلم. أَكلّ هَذَا الدَّم.. لإسكات قلم؟ وكلّ هذه المتفجرات المزروعة تحت مقعدكَ.. فقط لأنكَ رفضت أن تجلس يوماً على المبــــادئ؟ صاحــب “القلم الوسيم” سقط في موكب من مواكب الموت اللبناني. سَقَطَ، وما نَفع كلُّ هذا المجد الْمُتأخِّـــر، لموت يغطِّي الصفحات الأُولى للصحافة العالمية؟ ما زهو صور لم يجفّ دم صاحبها، تتقاسم على جدران بيروت حيِّـزاً كان محجوزاً للمطربين، وغَـدَا حكراً على الْمُنْتَخبِين والْمُقَاولِين السياسيين وصائــــدي الصّفقَــات؟ هو صائــد الكلمات، ماذا يفعل بينهم، وهو الذي عندما كان حيَّــاً ما كان ليمد يده ليُصافح بعضهم؟ وما نفع إكليل البطولة على رأس ما عاد رأسه مذ ركب سيارته وأدار ذلك الْمُحرِّك، فتطاير دمه، وتناثرت أجزاؤه لتتبعثَر فينا؟ القَتَلَـــة يقرأون الآن أخبار نَـعْـيِـهِ بعدما أسكتوه، وصنعوا من جثته عِبْـرَة انتخابية لنصرة “حزب الصّمت”، يبتسمون لكلّ هذا الرثــــاء أثناء حشو مسدّساتهم بـ”كاتم الصوت”. صَمَتَ “القلم الوسيم”، تاركاً لنا عالماً من البشاعة والذعر من المجهول، بينما نحنُ منهمكون في الْمُطالَبَـة بحقيقة جديدة تحمل رقم الشهيد الجديد. القَتَلَة يبتسمون مستخفِّين بمطالبنا، واثقين بجبننا. ذلك أنّ للحقيقة “كلاب حراسة” تسهر على سرّها. وحدهم حرّاس القيم لا حارس لهم إلاّ الضمير، الضمير الذي كان سبباً في استشهاد سميــر قصيــر. |
||||||

|
|
|
#7 | ||||||
|
مشرف
|
إلى إيطاليا.. مع حبي في رومــــا، تذكّرت أغنية الراحلة ميلينا مركوري، التي كانت في تشرُّدها النضالي تغنّي “حيث أُسافر تجرحني اليونان”، قبل أن تصبح وزيرة للثقافة في اليونان الديمقراطية· مثلها، ما سافرت إلى بلد إلاّ وجرحتني هموم العروبة· وكنت جئت إلى روما، لحضور الحفل الذي قدّمته بنجاح كبير صديقتي المطربة الملتزمة جاهدة وهبي، في قاعة “بيو” الضخمة، التابعة لحاضرة الفاتيكان، وذهب ريعه لبناء مستشفى لأطفال الناصرية· كان أهالي الجنود الإيطاليين الذين سقطوا في الناصرية، مُتأثرين ومُؤثرين في حضورهم إلى جانب أبناء الجالية العربية· فبعض أمهات وزوجات الجنود القتلى لم يخلعن حدادهن منذ عدة أشهر، لكنهن، على الرغم من ذلك، واصلن تضامنهن مع الشعب العراقي، لاعتقادهن أنَّ أبناءهن ذهبوا بنوايا إنسانية، لا في مهمة عدوانية كما خطَّط لها بعد ذلك البنتاغون· إحدى أرامل الحرب، أبدت أُمنيتها لزيارة الناصرية، المدينة التي دفع زوجها حياته ثمناً “لإعادة البسمة إلى أبنائها”· أما فكرة الحفل، فقد ولدت من تصريح شقيق أحد الجنود الضحايا، غداة مقتل أخيه، حين قال: “مَن يريد تقديم تعازيه لي·· ليواصل جمع المال من أجل الأطفال الذين كان أخي يقدِّم لهم العون”· وقد نقلت وسائل الإعلام الإيطالية، آنذاك، قصة ذلك الجندي القتيل، الخارج لتوِّه من الفتوَّة، الذي درج على تناول وجباته الغذائية برفقة عدد من الأطفال العراقيين، واعتاد أن يقتطع من مصروفه مبلغاً يوزعه عليهم· بعد موته، اكتشف الأطفال الذين ظلُّوا يترددون على مواقع العسكر، أن الجنود ليسوا جميعهم ملائكة، فقد غدت طفولتهم وجبة يومية للموت الأميركي الشَّـره· بعد ذلك الحفل، أخذتْ إقامتي في روما منحىً عراقياً لم أتوقعه· أسعدني اكتشاف مدى حماسة بعض الإيطاليين للقضايا العربية، بقدر ما آلمني ألاَّ يجد هؤلاء أي سند، ولا أي امتنان من الجهات العربية في روما، أو من العرب أنفسهم، الذين لا يدلّلون ولا يسخون إلاّ على أعدائهم· واحدة من هؤلاء الإيطاليين الرائعين، الجميلة ماورا غوالكو، التي اعتادت الحضور إلى لبنان كل 16 أيلول، مع وفد من الإيطاليين اليساريين الصحافيين في معظمهم، الناشطين في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك لإحياء الذكرى المأساوية لمذابح صبرا وشاتيلا، “ماورا” قالت لي بأسى، إنها ستتخلّف لأوّل مرّة منذ خمس سنوات عن هذا الموعد، لأنها ستضع مولودها في أيلول المقبل· ولكن رفاقها سيحضرون ليضعوا وروداً على مكان المذبحة، الذين فوجئوا عندما زاروه لأول مرة، بأنه تحوَّل إلى محل لرمي النفايات، فقاموا بتنظيفه بأنفسهم· وعندها استحت بلدية الغبيري، ووضعت شاهداً تذكارياً على ذلك المكان· المستشرقة الصديقة إيزابيلا دافليتو، نموذج آخر للإيطاليين الذين يكافحون لتجميل صورة العرب· فهي تحاول بمفردها منذ سنوات، إنقاذ سمعة الأدب العربي، والإشراف على ترجمة أهم الأعمال الأدبية، في سلسلة تصدر عن دار نشر “مناضلة” على الرغم من برجوازية صاحبها المحامي المسنّ، ما جعلني أتردّد في المطالبة بحقوقي، من ناشر تورَّط في حُب عربي مُفلس· كما يقوم عدَّة مثقفين موالين للعرب، بتنظيم ندوات فكرية أو سياسية، كتلك التي دُعيت إليها في مركز “بيبلي”، التي كانت مُخصصة للعراق، وألقيتُ خلالها نصاً شعرياً عن بغداد، تمت ترجمته للإيطالية· إيزابيلا دعتني، رغم مشاغلها، إلى عشاء في بيتها، دعت إليه على شرفي ناشري والبروفيسور وليام غرانارا، الأستاذ في جامعة هارفارد، والمستشرق الأميركي، الذي احتفظ بوسامة أصوله الإيطالية، وبحبِّه الأدب العربي·· ومشتقاته· وليام، الذي سبق أن التقيته في مؤتمر في القاهرة، اقترح دعوتي إلى أميركا لموسم دراسي ككاتبة زائرة، وناقشني بفصاحة مدهشة في رواياتي·· لكن من الواضح أنه لم يقرأ مقالاتي· لقائي الأكثر حرارة·· كان مع المخرج التلفزيوني داريو بلّيني، الذي سبق أن شاهدت له في مركز “بيبلي”، شريطاً وثائقياً عن بغداد، أبكى معظم الحاضرين، وهو يعرض يوميات العذاب والموت والإذلال، التي يعيشها العراقيون على أيدي جيش “التحرير” الأميركي· داريــو، الذي أُعجب بقصيدتي عن العراق، طلب مني أن يُصوّرها على شكل “كليب” لبرنامج ثقافي فـي التلفزيون الإيطالي· وهكذا قضيت آخر يوم برفقته، ورفقة الشاعرة ليديا فيلو، نُصوِّر القصيدة باللغتين، بعضها في بيت موسوليني، والبعض الآخر وسط المظاهرات العارمة، التي كانت يومها تجتاح شوارع روما، مندِّدة بالحرب الأميركية على العراق· إيطاليــــا العظيمة، لم تنجب فقط النصّابين والمافيوزي·· ومرتزقة الحروب، لقد أنجبت أيضاً مَن يعطون درساً في الإبداع·· وفي الإنسانية· |
||||||

|
|
|
#8 | ||||||
|
مشرف
|
جوارِبُ الشرفِ العربي
لا مفرّ لك من الخنجر العربيّ، حيث أوليت صدرك، أو وجّهت نظرك. عَبَثاً تُقاطِع الصحافة، وتُعرِض عن التلفزيون ونشرات الأخبار بكلّ اللغات حتى لا تُدمي قلبك. ستأتيك الإهانة هذه المرّة من صحيفة عربية، انفردت بسبق تخصيص ثلثي صفحتها الأُولى لصورة صدّام وهو يغسل ملابسه. بعد ذلك، ستكتشف أنّ ثَـمَّـة صوراً أُخرى للقائد المخلوع بملابسه الداخلية، نشرتها صحيفة إنجليزية “لطاغية كَرِهْ، لا يستحقّ مجاملة إنسانية واحدة، اختفى 300 ألف شخص في ظلّ حكمه”. الصحيفة التي تُباهي بتوجيهها ضربة للمقاومة “كي ترى زعيمها الأكبر مُهاناً”، تُهِينكَ مع 300 مليون عربيّ، على الرغم من كونك لا تقاوم الاحتلال الأميركي للعراق إلاّ بقلمك.. وقريباً بقلبك لا غير، لا لضعف إيمانك، بل لأنهم سيكونون قد أخرسوا لسانك. هؤلاء، بإسكات صوتك، وأولئك بتفجير حجّتك ونسف منطقك مع كلِّ سيارة مفخخة. تنتابك تلك المشاعر الْمُعقَّدة أمام صورة القائد الصنم، الذي استجاب اللّه لدعاء “شعبه” وحفظه من دون أن يحفظ ماء وجهه. وها هو في السبعين من عمره، وبعد جيلين من الْمَوتَى والْمُشرَّدين والْمُعاقِين، وبعد بضعة آلاف من التماثيل والصور الجداريّة، وكعكات الميلاد الخرافيّة، والقصور ذات الحنفيّات الذهبيّة، يجلس في زنزانة مُرتدياً جلباباً أبيض، مُنهمِكاً في غسل أسمال ماضيه و”جواربه القذرة”. مشهد حميميّ، يكاد يُذكّرك بـ”كليب” نانسي عجرم، في جلبابها الصعيدي، وجلستها العربيّة تلك، تغسل الثياب في إنــاء بين رجليهــا، وهي تغني بفائض أُنوثتها وغنجها “أَخاصمَــك آه.. أسيبـــك”. ففي المشهدين شيء من صورة عروبتك. وصدّام بجلبابه وملامحه العزلاء تلك، مُجرّداً من سلطته، وثياب غطرسته، غدا يُشبهك، يُشبه أبَــــاك، أخـــاك.. أو جنســك، وهذا ما يزعجك، لعلمك أنّ هذا “الكليب” الْمُعدّ إخراجه مَشهَدِيـــاً بنيّــة إذلالكَ، ليس من إخراج ناديـــن لبكــي، بل الإعلام العسكري الأميركيّ. الطّاغيــة الذي وُلِد برتبة قاتل، ما كانت له سيرة إنسانية تمنحك حقّ الدِّفاع عن احترام خصوصيته، وشرح مظلمته. لكنه كثيراً ما أربَككَ بطلّته العربيّة تلك. لـــذا، كلُّ مرَّة، تلوَّثَ شيءٌ منكَ وأنتَ تراه يقطع مُكرَهاً أشواطاً في التواضُع الإنساني، مُنحدراً من مجرى التاريخ.. إلى مجاريــه. الذين لم يلتقطوا صوراً لجرائمه، يوم كان، على مدى 35 سنة، يرتكبها في وضح النهار، على مرأى من ضمير العالَم، محوّلاً أرض العراق إلى مقبرة جَمَاعية في مساحة وطن، وسماءه إلى غيوم كيماوية مُنهطلة على آلاف المخلوقات، لإبادة الحشرات البشرية، يجدون اليوم من الوقت، ومن الإمكانات التكنولوجيّة المتقدمة، ما يتيح لهم التجسس عليه في عقر زنزانته، والتلصُّص عليه ومراقبته حتى عندما يُغيِّـر ملابسه الداخلية. في إمكان كوريا أَلاّ تخلع ثيابها النووية، ويحق لإسرائيل أن تُشمِّر عن ترسانتها. العالَم مشغول عنهما بآخر ورقة توت عربيّة تُغطِّي عـــورة صـــدّام. حتى إنّ الخبر بدا مُفرحاً ومُفاجئاً للبعض، حــدّ اقتراح أحد الأصدقاء “كاريكاتيراً” يبدو فيه حكّام عُــــراة يتلصصون من ثقب الزنزانة على صدّام وهو يرتدي قطعة ثيابه الداخلية. فقد غدا للطاغية حلفاؤه عندما أصبح إنساناً يرتدي ثيابه الداخلية ويغسل جواربه. بدا للبعض أنظف من أقرانه الطُّغاة المنهمكين في غسل سجلاتهم وتبييض ماضيهم.. تصريحاً بعد آخر، في سباق العري العربيّ. أنا التي فَاخَرتُ دومَــاً بكوني لم أُلـــوِّث يــدي يوماً بمصافحة صدّام، ولا وطأت العراق في مرابــد الْمَديــح وسوق شراء الذِّمم وإذلال الهِمَم، تَمَنَّيتُ لو أنني أخذتُ عنه ذلك الإنـــاء الطافح بالذلّ، وغسلت عنه، بيدي الْمُكابِـرَة تلك، جوارب الشّرف العربيّ الْمَعرُوض للفرجـــــة. |
||||||

|
|
|
#9 | ||||||
|
مشرف
|
أمنيات نسائية.. عكس المنطق طالما تردّدت في الاعتراف بأحلامي السريّة، خشية أن تهاجمني الحركات النسويّة. وحدي ناضلت كي يعيدني حبّك إلى عصور العبودية، وسرت في مظاهرة ضد حقوق المرأة، مطالبة بمرسوم يفرض على النساء الحجاب، ووضع البرقع في حضرة الأغراب، ويعلن حظر التجول على أي امرأة عاشقة، خارج الدورة الدموية لحبيبها. *** قبلك حققت حلم الأُخريات، واليوم، لا مطلب لي غير تحقيق حلمي في البقاء عصفورة سجينة في قفص صدرك، وإبقاء دقات قلبي تحت أجهزة تنصّتك، وشرفات حياتي مفتوحة على رجال تحرّيك. رجل مثلك؟ يا لروعة رجل مثلك، شغله الشاغل إحكام قيودي، وشدّ الأصفاد حول معصم قدري. أين تجد الوقت بربّك.. كي تكون مولاهم.. وسجّاني؟ امرأة مثلي؟ يالسعادة امرأة مثلي، كانت تتسوق في مخازن الضجر الأنثوي، وما عاد حلمها الاقتناء.. بل القِنانة، مذ أرغمتها على البحث عن هذه الكلمة في قاموس العبودية. وإذا بها تكتشف نزعاتك الإقطاعيّة في الحبّ. فقد كنت من السادة الذين لا يقبلون بغير امتلاك الأرض.. ومن عليها. كانت قبلك تتبضّع ثياباً نسائية.. عطوراً وزينة.. وكتباً عن الحرية. فكيف غدت أمنيتها أن تكون بدلة من بدلاتك.. ربطة من ربطات عنقك.. أو حتى حزام بنطلون في خزانة ثيابك. شاهدت على التلفزيون الأسرى المحررين، لم أفهم لماذا يبكون ابتهاجاً بالحريّة، ووحدي أبكي كلّما هدّدتني بإطلاق سراحي. ولماذا، كلّما تظاهرت بنسيان مفتاح زنزانتي داخل قفل الباب، عُدت لتجدني قابعة في ركن من قلبك. وكلّما سمعتُ بالمطالبة بتحقيق يكشف مصير المفقودين، خفتُ أن يتم اكتشافي وأنا مختفية، منذ سنوات، في أدغال صدرك. وكلّما بلغني أن مفاوضات تجرى لعقد صفقة تبادل أسرى برفات ضحايا الحروب، خفت أن تكون رفات حبّنا هي الثمن المقابل لحرّيتي، فرجوتك أن ترفض صفقة مهينة إلى هذا الحد.. ورحت أعدّ عليك مزايا الاعتقال العاطفي.. علني أغدو عميدة الأسرى العرب في معتقلات الحب. |
||||||

|
|
|
#10 | ||||||
|
مشرف
|
أميركا.. كما أراها
زرت أميركا مرَّة واحدة، منذ خمس سنوات.كان ذلك بدعوة من جامعة "ميريلاند" بمناسبة المؤتمر العالمي الأوّل حول جبران خليل جبران. كان جبران ذريعة جميلة لاكتشاف كوكب يدور في فلك آخر غير مجرَّتي.. يُدعى أميركا. حتى ذلك الحين، كنت أعتقد أنّ قوّة أميركا تكمُن في هيمنة التكنولوجيا الأكثر تطوراً، والأسلحة الأكثر فتكاً، والبضائع الأكثر انتشاراً. لكنني اكتشفت أنّ كل هذه القوّة تستند بدءاً على البحث العلميّ وتقديس المؤسسات الأكاديمية، واحترام الْمُبدعين والباحثين والأساتذة الجامعيين. فاحترام الْمُبدع والْمُفكِّر والعالِــم هنا لا يُعادله إلاّ احترام الضابط والعسكري لدينا. وربما لاعتقاد أميركا أنّ الأُمم لا تقوم إلاّ على أكتاف علمائها وباحثيها، كان ثـمَّـة خطة لإفراغ العراق من قُدراته العلمية. وليس هنا مجال ذكر الإحصاءات الْمُرعبــة لقدر علماء العراق، الذين كان لابدّ من أجل الحصول على جثمان العراق وضمان موته السريري، تصفية خيرة علمائه، بين الاغتيالات والسجن وفتح باب الهجرة لأكثر من ألف عالِم من عقوله الْمُفكِّرة، حتى لا يبقى من تلك الأُمّة، التي كانت منذ الأزل، مهـــد الحضارات، إلاّ عشائر وقبائل وقطَّاع طُرق يتقاسمون تجارة الرؤوس المقطوعة. لكن أميركا تفاجئك، لا لأنها تفعل كلَّ هذا بذريعة تحريرك، بل لأنها تعطيك درساً في الحريّة يربكك. خبرت هذا وأنا أطلب تأشيرة لزيارة أميركا، لتلبية دعوتكم هذه، ودعوة من جامعتي "ميتشيغن" و(MIT). فعلى الرغم من مُعاداتي السياسة الأميركية في العالَم العربي، لاعتقادي أنّ العدل أقلّ تكلفة من الحرب، و محاربة الفقر أجدى من محاربة الإرهاب، وأنّ إهانة الإنسان العربيّ وإذلاله بذريعة تحريره، هو إعلان احتقار وكراهية له، وفي تفقيره بحجّة تطويره نهب، لا غيرة على مصيره، وأنّ الانتصار المبنيّ على فضيحة أخلاقيّة، هو هزيمة، حتى إنْ كان المنتصر أعظم قوّة في العالم، وعلى الرغم من إشهاري هذه الأفكار في أكثر من منبر، مازالت كُتبي تُعتَمد للتدريس في جامعات أميركا. وكان يكفي أن أُقدِّم دعوات هذه الجامعات، لأحصل خلال ساعتين على تأشيرة لدخول أميركا مدَّة خمس سنوات. وهنا يكمن الفرق بين أميركا والعالَم العربيّ، الذي أنا قادمة منه، حيث الكتابة والثقافة في حدّ ذاتها شبهة، وحيث، حتى اليوم، يعيش الْمُبدعون العرب، ويموتون ويُدفَنون بالعشرات في غير بلدهم الأصلي. لقد اختصر الشاعر محمد الماغوط، نيابة عن كلِّ الْمُبدعين العرب، سيرته الحياتية والإبداعية في جملة واحدة "وُلِـدْتُ مذعــــوراً وسأموت مذعـــوراً". فالْمُبدع العربي لايزال لا يشعر بالأمان في بلد عربي. وإذا كان بعض الأنظمة يتردَّد اليوم قبل أن يسجن كاتباً أو يغتاله، فليس هذا كرماً أو نُبلاً منه، إنما لأن العالم قد تغيَّر، وأصبحت الجرائم في حق الصحافيين والْمُبدعين لا تُسمَّى بسرّية، وقد تُحاسبــه عليها أميركا كلّما جاءها، مُقدِّماً قرابين الولاء، مُطالِباً بالانتساب إلى معسكر الخير. ولذا اختار بعض الأنظمة العربية الدور الأكثر براءة، وتَمَادَى في تكريم وتدليل الْمُبدعين، شراءً للذِّمم، وتكفيراً عن جرائم في حق مثقفين آخرين. الحقيقة غير هذه، ويمكن أن تختبرها في المطارات العربية، وعند طلب تأشيرة "أخويّـــة"، وفي مكان العمل، حيث يُعامل الْمُبدع والْمُفكِّر والجامعي بما يليق بالإرهابيّ من تجسّس وحَذَر، وأحياناً بما يفوقه قَصَاصَاً وسجناً وتنكيلاً، بينما يجد في الغرب، وفي أميركا التي يختلف عنها في اللغة وفي الدين وفي المشاعر القوميّة، مَــــلاذاً يحضن حرّيته، ومؤسسات تدعم عبقريته وموهبته. وما معجزة أميركا إلاّ في ذكاء استقطاب العقول والعبقريات المهدورة، وإعادة تصديرها إلى العالَم من خلال اختراعات وإنجازات علميّة خارقة. ما الاُسد في النهاية سوى خرفان مهضومة. |
||||||

|
|
|
#11 | ||||||
|
مشرف
|
أن تكون كاتباً جزائرياً
" ألقيت هذه الشهادة في مؤتمر الروائيين العرب في القاهرة 1998 " عندما تكون كاتباً جزائرياً, وتأتيك الجزائر يومياً بقوافل قتلاها, بين اغتيالاتها الفردية, ومذابحها الجماعية, وأخبار الموت الوحشي في تفاصيله المرعبة, وقصص أناسه البسطاء في مواجهة أقدار ظالمة. لا بد أن تسأل نفسك ما جدوى الكتابة؟ وهل الحياة في حاجة حقاً الى كتّاب وروائيين؟ ما دام ما تكتبه في هذه الحالات ليس سوى اعتذار لمن ماتوا كي تبقى على قيد الحياة. وما دامت النصوص الأهم, هي ليست تلك التي توقّعها أنت باسم كبير, بل تلك التي يكتبها بدمهم الكتاب والصحافيون المعرفون منهم والذكرة, الصامدون في الجزائر. والواقفون دون انحناء بين ناري السلطة والإرهاب والذين دفعوا حتى الآن ستين قتيلاً.. مقابل الحقيقة وحفنة من الكلمات. عندما تكون كاتباً جزائرياً مغترباً, وتكتب عن الجزائر, لا بد أن تكتب عنها بكثير من الحياء, بكثير من التواضع, حتى لا تتطاول دون قصد على قامة الواقفين هناك. أو على أولئك البسطاء الذين فرشوا بجثثهم سجاداً للوطن. كي تواصل أجيالاً أخرى المشي نحو حلم سميناه الجزائر. والذين على بساطتهم, وعلى أهميتك, لن يرفعك سوى الموت من أجل الجزائر الى مرتبتهم. الجزائر التي لم تكن مسقط رأسي بل مسقط قلبي وقلمي, ها هي ذي تصبح مسقط دمي. والأرض التي يقتل عليها بعضي بعضي, فكيف يمكنني مواصلة الكتابة عنها ولها. واقفة على مسافة وسطية بين القاتل والقتيل. لقد فقدنا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة أكثر من ستين كاتب ومبدع. هم أكثر من نصف ثروتنا الإعلامية. ولم يبق لنا من الروائيين أكثر من عدد أصابع اليدين في بلد يفوق سكانه الثلاثين مليون نسمة, أي انه لا يوجد في مقابل كل مليون جزائري, كاتب واحد ينطق ويكتب ويحلم ويفكر باسم مليون شخص. فأي نزيف فكري هو هذا؟.. وأيّة فاجعة وطنية هي هذه! ولذا كلما دعيت الى ملتقى حول الكتابة بدأ لي الجدل حول بعض المواضيع النقدية أو الفنية أمراً يقارب في طرحه مسرح العبث.. عندما يتعلّق الأمر ببلد يشكل فيه الكاتب في حد ذاته نوعاً بشرياً على وشك الإنقراض, وتشكّل فيه الكتابة في حد ذاتها تهمة لم يعد الكاتب يدري كيف يتبرّأ منها.. وذنباً لم يعد يدري كيف يجب أن يعلن توبته عنه أمام الملأ ليتمكن أخيراً من العيش بأمان. فما الذي حلّ بنا اليوم؟ منذ الأزل نكتب وندري أن في آخر كل صفحة ينتظرنا رقيب ينبش بين سطورنا, يراقب صمتنا وأنفاسنا, ويتربص بنا بين جملتين. كنا نعرف الرقيب ونتحايل عليه. ولكن الجديد في الكتابة اليوم أننا لا ندري من يراقب من.. وما هي المقاييس الجديدة للكتابة. الجديد في الكتابة اليوم, أنّ أحلامنا تواضعت في بضع سنوات. فقد كنا نحلم أن نعيش يوماً بما نكتب.. فأصبحنا نحلم ألا نموت يوماً بسبب ما نكتب. كنا نحلم في بدايتنا أن نغادر الوطن ونصبح كتاباً مشهورين في الخارج. اليوم وقد أصبحنا كذلك أصبح حلمنا أن نعود الى وطننا ونعيش فيه نكرات لبضعة أيام. كنا نحلم بكتابة كتب جديدة.. أصبحنا نحلم بإعادة طبع كتبنا القديمة ليس أكثر .. فالذي كتبناه منذ عشرين سنة لم نعد نجرؤ على كتابته اليوم. عندما تكون كاتباً جزائرياً. كيف لك اليوم أن تجلس لتكتب شيئاً في أي موضوع كان دون أن تسند ظهرك الى قبر. في زمن العنف العدميّ, والموت العبثي, كم مرة تسأل نفسك. ماذا تكتب؟ ولمن؟ داخلاً في كل موت في حالة صمت حتى تكاد تصدّق أنّ في صمت الكاتب عنفاً أيضاً. ماذا تكتب أيّها الروائي المتذاكي.. ما دام أيّ مجرم صغير هو أكثر خيالاً منك. وما دامت الروايات اكثر عجائبية وإدهاشاً تكتبها الحياة.. هناك. سواء أكانت تريد أن تكتب قصة تاريخية, أم عاطفية أو بوليسية. رواية عن الرعب أ عن المنفى. عن الخيبة, عن المهزلة, عن الجنون.. عن الذعر.. عن العشق.. عن التفكك.. عن التشتت عن الموت الملفّق.. عن الأحلام المعطوبة.. عن الثروات المنهوبة أثناء ذلك بالملايين بين مذبحتين. لا تتعب نفسك, لقد سبقتك جزائر الأكاذيب والخوف وكتبتها. الحياة هي الروائي الأول في الجزائر. وأنت, أيّها الروائي الذي تملك العالم بالوكالة, وتدير شؤونه في كتاب. الذي يكتب قطعاً ليس أنت. ما دمت تكتب بقلم قصصاً يشاركك القدر في كتابتها بالدم. كنا نحلم بوطن نموت من أجله.. فأصبح لنا وطن نموت على يده. فلماذا تكتب؟ ولمن؟ وكيف يمكن فضّ الاشتباك بينك ككاتب والوطن؟ وهل المنفى هو المكان الأمثل لطرح تلك الأسئلة الموجعة أكثر من أجوبتها. أراغون الذي قال صدقتها "الرواية أي مفتاح الغرف الممنوعة في بيتنا" لم يكن عربياً. وإلا لكان قال "إن الرواية هي مفتاح الأوطان المغلقة في وجهنا. إنه التعريف الأنسب للرواية المعاصرة, التي منذ جيلين أكثر تولد في المنافي القسرية أو الإختيارية. موزعة على الخرائط العربية والغربية. هناك حيث ينتظر عشرات المبدعين العرب موتهم. حالمين أن يثأروا يوماً لغربتهم بالعودة في صناديق مفخخة بالكتب, فيحدثوا أخيراً ذلك الدوي الذي عاشوا دون أن يسمعوه: دويّ ارتطامهم بالوطن. إنه زمن الشتات الجزائري إذن. وطن يفرغ ليتبعثر كتّابه ومثقفوه بين المقابر والمنافي ليواصلوا الميراث التراجيدي للكتابة العربية, وينضمّوا للشتات الفلسطيني وللشتات العراقي.. والشتات غير المعلن لأكثر من بلد عربي, تنفى منه شعوب بأكملها, وتنكسر فيه أجيال من الأقلام إكراماً لرجل أو لحفنة من الرجال, يفكرون بطريقة مختلفة ولا يغفرون لك ان تكون مختلفاً. ذلك ان الكتابة أصبحت الآن أخطر مهنة. والتفكير أصبح أكبر تهمة, حتى أنه يشترك مع التكفير في كل حروفه ويبدو أمامه مجرد زلة لسان. فلماذا نصرّ إذن على التفكير؟ ولماذا نصرّ على الكتابة؟ وهل يستحق أولئك الذين نكتب من أجلهم كل هذه المجازفة؟ إن وطناً أذلّنا أحياء لا يعنينا أن يكرّمنا امواتاً. ووطناً لا تقوم فيه الدولة سوى بجهد تأمين علم وطني تلف به جثماننا, هو وطن لا تصبح فيه مواطناً إلا عندما تموت. يبقى أن الذين يتحملّون جريمة الحبر الجزائري ليسوا القتلة. والذين يحملون على يدهم آثار دم لما يقارب المائة ألف شخص كانوا يعيشون آمنين.. ليسوا التقلة. وإنما أولئك الذين لم تمنعهم كلّ فجائعنا من مواصلة الحياة بالطمأنينة والرخاء نفسه, والذين استرخصوا دمنا.. حتى أصبح الذبح والقتل أمراً عادياً لا يستوقف في بشاعته حتى المثقفين العرب أنفسهم. والذين تفرّجوا خلال السنوات الأخيرة بلا مبالاة مدهشة على جثتنا. والذين جعلوننا نصدق ذلك الكاتب الذي قال: "لا تخش أعداءك, ففي أسوأ الحالات يمكنهم قتلك لاتخش أصدقاءك ففي أسوأ الحالات يمكنهم خيانتك إخش اللامبالين فصمتهم يجيز الجريمة والخيانة". |
||||||

|
|
|
#12 | ||||||
|
مشرف
|
أنا في المطبخ.. هل من مُنازل؟
مــذ التحقت بوظيفتي كـ"ست بيت" وأنا أُحاول أن أجد في قصاص الأشغال المنزلية متعة ما، تخفّف من عصبيتي الجزائرية في التعامل مع الأشياء. قبل أن أعثر على طريقة ذكيّة لخوض المعارك القوميّة والأدبيّة أثناء قيامي بمهامي اليوميّة. وهكـــذا، كنت أتحارب مع الإسرائيليين أثناء نفض السجّاد وضربه، وأرشّ الإرهابيين بالمبيدات أثناء رشِّي زجاج النوافذ بسائل التنظيف، و"أمسح الأرض" بناقد أو صحافي أثناء مسحي البلاط وتنظيفه، وأتشاجر مع قراصنة كتبي ومع المحامين والناشرين أثناء غسل الطناجر وحكّها بالليفة الحديديّة، وأكوي "عذّالي" وأكيد لهم أثناء كيّ قمصان زوجي، وأرفع الكراسي وأرمي بها مقلوبة على الطاولات كما لو كنتُ أرفع بائعاً غشّني من عنقه. أمّا أبطال رواياتي، فيحدث أن أُفكِّر في مصيرهم وأدير شؤونهم أثناء قيامي بتلك الأعمال اليدوية البسيطة التي تسرق وقتي، من دون أن تستدعي جهدي، وفي إمكاني أن أحل كلّ المعضلات الفلسفية وأنا أقوم بها، من نوع تنظيف اللوبياء، وحفر الكوسة، وتنقية العدس من الحصى، أو غسل الملوخيّة وتجفيفها. حتى إنني، بعد عشرين سنة من الكتابة المسروقة من شؤون البيت، أصبحت لديّ قناعة بأنه لا يمكن لامرأة عربيّة أن تزعم أنها كاتبة ما لم تكن قد أهدرت نصف عمرها في الأشغال المنزلية وتربية الأولاد، ولا أن تدّعي أنها مناضلة، إن لم تكن حاربت أعداء الأُمّة العربية بكلّ ما وقعت عليه يدها من لوازم المطبخ، كما في نداء كليمنصو، وزير دفاع فرنسا أثناء الحرب العالمية الأُولى، عندما صاح: "سنُدافع عن فرنسا، ونُدافع عن شرفها، بأدوات المطبخ والسكاكين.. بالشوك بالطناجر، إذا لزم الأمر"! كليمنصو، هو الرجل الوحيد في العالم الذي دُفن واقفاً حسب وصيّته، ولا أدري إذا كان يجب أن أجاريه في هذه الوصيّة لأُثبت أنني عشت ومتّ واقفة في ساحة الوغى المنزلية، خلف الْمَجلَى وخلف الفرن، بسبب "الزائدة القوميّة" التي لم أستطع استئصالها يوماً، ولا زائدة الأُمومة التي عانيتها. يشهد اللّه أنني دافعت عن هذه الأُمة بكلّ طنجرة ضغط، وكلّ مقلاة، وكلّ مشواة، وكلّ تشكيلة سكاكين اشتريتها في حياتي، من دون أن يُقدِّم ذلك شيئاً في قضيّة الشرق الأوسط. وكنت قبل اليوم أستحي أن أعترف لسيدات المجتمع، اللائي يستقبلنني في كلّ أناقتهن ووجاهتهنّ، بأنني أعمل بين كتابين شغالة وخادمة، كي أستعيد الشعور بالعبوديّة الذي عرفته في فرنسا أيام "التعتير"، الذي بسببه كنت أنفجر إبداعاً على الورق، حتى قرأت أنّ سفير تشيكيا في بريطانيا، وهو محاضر جامعي سابق، قدَّم طلباً لعمل إضافيّ، هو تنظيف النوافذ الخارجيّة في برج "كاناري وورف" المشهور شرق لندن، لا كسباً للنقود، وإنّما لأنه عمل في هذه المهنة في الستينات، ويُريد أن يستعيد "الشعور بالحريّة"، الذي كان يحسّ به وهو مُتدلٍّ خارج النوافذ، مُعلَّقاً في الهواء، يحمل دلواً وإسفنجة. غير أنّ خبراً قرأته في مجلة سويسرية أفسد عليّ فرحتي بتلك المعارك المنزلية، التي كنت أستمدّ منها زهوي. فقد نجحت سيدة سويسرية في تحويل المكنسة ودلو التنظيف إلى أدوات فرح، بعد أن تحوّلت هي نفسها من مُنظِّفة بيوت إلى سيدة أعمال، تعطي دروساً في سويسرا والنمسا وألمانيا حول أساليب التمتُّع بعذاب الأشغال المنزلية، بالاستعانة بالموسيقى والغناء ودروس الرقص الشرقي وتنظيم التنفُّس. أمّـا وقد أصبح الجلي والتكنيس والتشطيف يُعلَّم في دروس خصوصية في جنيف وفيينا على وقع موسيقى الرقص الشرقي، فحتماً ستجرّدني بعض النساء من زهوي باحتراف هذه المهنة. بل أتوقّع أن يحضرن بعد الآن إلى الصبحيات وهنّ بالمريول ("السينييه" طبعاً) خاصة أنّ هيفاء وهبي وهي تتنقّل بمريولها الْمُثير في ذلك "الكليب" بين الطناجر والخضار، نبّهت النساء إلى أنّ المعارك الأشهى والحاسمة تُدار في المطابخ! |
||||||

|
|
|
#13 | ||||||
|
مشرف
|
إنهم يقضمون تفاحة الحياة كلّما طالعت في الصحف أخبار "صباح"، التي تنتظر في أميركا التحاق خطيبها العشريني الوسيم بها، حال حصوله على تأشيرة، مستعينة على أمنيتها أن تحبل منه، بإشهار دبلة خطوبتها في وجه شهادة ميلادها، آمنتُ بالحب كنوع من اللجوء السياسي، هرباً من ظلم "أرذل العمر"، وصدّقت أن علّة الحياة: قلّة الأحياء رغم كثرة عددهم. ذلك أن الأحياء بيننا، ماعادوا الشباب.. بل الأثرياء.. وبعض المسنين الحالمين، الذين لا يتورعون عن إشهار وقاحة أحلام، لا نملك جسارة التفكير فيها، برغم أننا نصغرهم سنّاً. فهل الاقتراب من الموت يُكسب الإنسان شجاعة، افتقدها قبل ذلك، في مواجهة المجتمع؟ أغرب الأخبار وأجملها، أحياناً تأتينا من المسنين، الذين يدهشوننا كل يوم، وهم يقضمون أمامنا تفاحة الحياة بملء أسنانهم الاصطناعية، ويذهبون متكئين على عكازتهم نحو أسرَّة الزوجية وليلة فتوحاتهم الوهمية، مقترفين حماقات جميلة، نتبرأ من التفكير فيها، غير معنيين بأن يتركوا جثتهم قرباناً، على سرير الفرحة المستحيلة. وبعض النهايات المفجعة لهؤلاء اللصوص الجميلين، الذين يحترفون السطو على الحياة، تعطينا فكرة عن مدى روعة أُناس يزجُّون بقلوبهم في الممرات الضيقة للسعادة، فيحشرون أنفسهم بين الممكن والمستحيل، مفضلين، وقد عجزوا عن العيش عشاقاً، أن يموتوا عشقاً، ويصنعوا بأخبارهم طرائف الصحف اليومية، كذلك المسن المصري، الذي فشل في تحقيق حلم حياته، بأداء واجباته الزوجية مع عروسه الشابة، التي تزوجها منذ بضعة أيام، مستخدماً في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، الذي رغم استعانته ببركات "الفياغرا"، لم يتمكن من الدخول بعروسه الحسناء، فسكب البنزين على جسده، وقرر أن يموت حرقاً، بعد أن فشل في تحقيق آخر أحلامه، أو كعجوز الحب الفرنسية، التي لم يتحمل قلبها، وهي في الثامنة والسبعين من عمرها، الفرحة، فتوقف عن النبض قبل ساعات قليلة من عقد قرانها على زميلها في دار المسنين، الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، بينما كانت منهمكة مع بقية النزلاء في تزيين دار العجزة استعداداً للمناسبة! وإذا كانت الفرحة قاتلة، بالنسبة إلى النساء، فالغيرة تبدو العاطفة التي تعمر أكثر في قلوب الرجال، وقد تحولهم في أي عمر إلى قتلة، كقصة ذلك الزوج التسعيني، الذي كان يتبادل مع زوجته العجوز أطراف الذكريات البعيدة، عندما أخبرته في لحظة فلتان لسان نسائي، أنه بينما كان مجنداً في الحرب العالمية الثانية، خانته مع رجل عابر. فلم يكن من الرجل إلاّ أن غافلها وخنقها ليلاً، انتقاماً لخيانة تعود لنصف قرن! أو ذلك المعمر الفرنسي، البالغ 89 سنة، الذي يقبع في سجون فرنسا، كأكبر معتقل، إثر حكم عليه بالسجن بتهمة خنق وضرب زوجته، البالغة من العمر 83 عاماً، حتى الموت، بعد أن عثر تحت وسادتها على رسائل غرامية، يتغزل فيها بها معجب، ليس في عمر "عمر محيو" خطيب صباح، وإنما رجل يبلغ ثمانين عاماً، يصغرها بثلاث سنوات! غير أن العشاق من المسنين، ليسوا جميعهم مشروعات مجرمي حب، بل ثمة العشاق الأبديون الحالمون.. كذلك الجندي الأميركي، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، ومازال منذ ذلك الحين دائم البحث عن المرأة، التي وقع في حبها في ألمانيا، التي مازالت حلم عمره، حتى إنه نشر صورته بالزي العسكري، مرفقة برسالة موجهة إلى جميع "السيدات اللواتي تجاوزن السبعين من العمر"، يطلب فيها من حبيبته الاتصال به، والجواب عن بعض الأسئلة.. بل إن الحب مازال يزوِّد المسنين بطاقة خرافية للحلم، وبشهية مخيفة للحياة، كما في طهران، حيث وافقت المحكمة على زواج رجل، في الخامسة والثمانين من عمره، بامرأة في الخامسة والسبعين من عمرها.. بعد أن سبق لأهلها منذ 50 سنة أن رفضوا تزويجه بها! أما في تونس، فمازال البعض يذكر إحدي أجمل قصص الحب، التي انتهت بعقد قران رجل في السابعة والتسعين من العمر على عروسه، البالغة 86 عاماً، وتلك الأفراح التي دامت آنذاك سبعة أيام، وسبع ليالٍ كاملة، نظراً لكثرة أفراد عائلتي الزوجين، التي تضم 42 حفيداً، من جهة العريس، الذي يبلغ ابنه البكر الخامسة والسبعين من عمره.. و11 ابناً و33 حفيداً من جهة العروس. "برافو |
||||||

|
|
|
#14 | ||||||
|
مشرف
|
أيها الرب ...........إذا جعلتني أقوى إذا كان ما حدث في أميركا في "صباح الطائرات"، قد تطلّب منّا وقتاً لتصديق غرائبيّته وهَوْلِـه، فإنّ الكتابة عنه، بقدر من الموضوعية والإنسانية، كانت تتطلّب منّـا أيضاً بعض الوقت، كي نتجاوز أحاسيسنا الأُولى، ونعي أنّ تلك الأبراج الشاهقة، التي كانت "مركز الجشع العالمي"، التي انبهر الملايين من بؤساء العالم وجياعه ومظلوميه، وهم يشاهدون انهيارها، لم تكن مجرّد مبانٍ تُناطح السحَاب غروراً، بل كانت تأوي آلاف البشر الأبرياء، الذين لن يعرفوا يوماً لماذا ماتــوا، والذين كانوا لحظة انهيارها يُدفنون تحت أنقاضها، ويموت العشرات منهم، محترقين بجنون الإرهاب، دون أن يتمكَّن أهلهم من التعرّف حتى إلى أشلائهم المتفحّمة، ليكون لهم عزاء دفنهم أو زيارة قبورهم في ما بعد. لــم تكن المباني إذن مِن ديكورات الكارتون، كما يتمُّ تجسيمها عادة في استديوهات هوليوود، عندما يتعلَّق الأمر بخدع في فيلم أميركي يصوّر نهاية العالم: فكيف انهارت بتلك السرعة الْمُذهلة، وجعلتنا نكتشف، مذعورين، هشاشة الْمَفاخر التكنولوجية، والحضارة العصرية، القائمة على الْمُزايدات التقنية، والتشاوف بين الأُمم؟ ذلك أن الكثيرين، من الذين ماتــوا تلك الميتة الشنيعة، قضوا أعمارهم في أكبر الجامعات وأغلاها، كي يتمكّنوا يوماً من تسلُّق سلّم الأحلام، والوصول إلى أعلى ناطحة سحاب في العالم، حيث ينبض "جيب" الكرة الأرضية وماداموا لم يسمعوا بابن المعتز، وإنما ببيل غيتس، نبيِّ المعلوماتية ورسولها إلى البشرية، فقد فوّتوا عليهم نصيحة شاعر عربي قال: "دعي عنكِ المطامع والأماني --- فكم أمنيةٍ جلبت منيّة" ساعة و44 دقيقة فقط، هو الوقت الذي مرَّ بين الهجوم على البرج الأول وانهيار البرجين وإذ عرفنا أن الوقت الذي مـرَّ بين ارتطام عابرة المحيطات الشهيرة "تايتانيك" بجبل جليدي وغرقها، كان حسب أرقام الكوارث ساعتين وأربعين دقيقة، بينما تطلَّب إنجازها عدَّة أعوام من التخطيط والتصميم، وكلَّفت أرقاماً خُرافية في تاريخ بناء البواخر، وكذلك سقوط طائرة "الكونكورد" الأفخم والأغلى والأسرع لنقل الركّاب في العالم، واحتراقها (بركابها الأثرياء والمستعجلين حتماً)، في مــدّة لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة، وإيقاف مشروع تصنيعها لحين، بخسارة تتجاوز آنذاك مليارات الفرنكات، أدركن هشاشة كلّ ما يزهو به الإنسان، ويعتبره من علامات الوجاهة والفخامة والثراء، ودليلاً على التقنيات البشرية المتقدمة، التي يتحدّى بها البحر حيناً، لأنه يركب أضخم وأغلى باخرة، ويتحدّى بها السماء حينا آخر، لأنه يجلس فوق أعلى وأغلى ناطحة سحاب، جاهلاً أن الإنسان ما صنع شيئاً إلاّ وذهب ضحيته، ولــذا عليه أن يتواضع، حتى وهو متربّع على إنجازاته وقد كان دعاء أمين الريحاني "أيّها الربُّ إذا جعلتني أقوى، فاجعلني أكثر تواضُعاً". أميركا التي خرجت إلينا بوجه لم نعرفه لها، مرعوبة، مفجوعة، يتنقّل أبناؤها مذهولين، وقد أطبقت السماء عليهم، وغطَّى الغُبار ملامحهم وهيأتهم، لكأنَّـهـم كائنات قادمة إلينا من المرِّيخ، لفرط حرصهم على الوصول إليه قبلنا، أكانت تحتاج إلى مُصَابٍ كهذا، وفاجعة على هذا القدر من الانفضاح، لتتساوى قليلاً بنا، نحنُ جيرانها، في الكرة الأرضية، الذين نتقاسم كوارث هذا الكواكب كلَّ يوم؟ ذلك أنه منذ زمن، والأميركيون جالسون على علوّ مئة وعشرة طوابق من مآسينا فكيف لصوتنا أن يطالهم؟ وكيف لهم أن يختبروا دمعنا؟ لــم يكن إذن ما رأيناه في الحادي عشر من أيلول، مشهداً من فيلم عوَّدتنا عليه هوليوود كان فيلماً حقيقياً عن "عولمة الرعب"، بدمار حقيقي وضحايا حقيقيين، بعضهم كان يعتقد آنذاك أنه يتفرّج على "الفيلم"، عندما وجد البرجين ينهاران فوق رأسه وكما في السينما، كان السيناريو جاهزاً بأعداء جاهزين المفاجأة أننا ما كنّـا نتوقع أن يتمّ اختيارهم بقرعة الجغرافيا من بين الْمُشاهديـــن. لا جـــدوى مِن الإسراع إلى إطفاء جهاز التلفزيون ذلك أنَّ "النسر النبيل"، هو الذي يختار في هذا الفيلم الأميركي الطويل، لِمَن مِن المشاهدين سيُلقّن درساً ومتى، فهو الذي يقرّر إلى مَنْ منّـا سيسند دور الشرِّير. |
||||||

|
|
|
#15 | ||||||
|
مشرف
|
ابتسم أنت في امريكا
يدهشك حقا ويعنيك أهمية الجامعات في تأسيس أمريكا ، انها تنب كالجزر والواحات في الولايات وتصنع فخر الأمريكي الذي تخرج منها والذي يدين لها بولاء يبخل به حتى على عائلته ، أحدهم جاء من المكسيك كان مزارعا تابع دروسه الليلية في جامعة ميريلاند وعاد منذ مدة وقد اصبح مهندسا كبيرا ليدفع 5 ملايين دولار مساعدة منه للجامعة ولمن يتعلم بعده فيها ولانك لاتمنع نفسك من المقارنه فستتذكر ذلك السفير الجزائري الذي كان يحتفظ بمنح الطلبة في الخارج لعدة اشهر في حسابه الخاص للاستفادة من فوائدها ولا يحولها لهم الا عندما يشارفون على التسول وعندما تتجول بعد ذلك في المباني الجامعية والمتشابهة بجامعة ميريلاند ستكتشف ان معظمها بنيت بهبات خريجي الجامعة الأثرياء ، وفي نزل ماريوت الذي تقيم فيه سيقع نظرك حيث ذهبت على لوحات جميلة وثمينة تزين الممرات والقاعات وستلحظ اسفلها صفيحة من البرونز وبخط صغير اسم واهبها الذي هو أحد خريجي الجامعة فتتذكر قصة معروفة لمدير سابق لإحدى الكليات اللبنانية الذي نهب نصف ميزانية الكلية أثناء الحرب بابتكاره فواتير مزورة لتجهيزات وهمية لم تحصل عليها الكلية ، ثم غادر الى وظيفة اكثر ربحا وقد ترك الكلية عارية من كل شئ وبعد قليل يأتي نادل لخدمتك في المطعم ويخبرك أحدهم انك قد تعود في المرة المقبلة وتجده موظفا في الطوابق العليا لان الجميع هنا يدرس ليتقدم ولا احد يشغل الوظيفة نفسها طوال حياته والفرص متاحة بالتساوي للجميع يحكى الأستاذ سهيل بشوئي احد عمدة أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت في الستينات والسبعينات انه استطاع برسالة الى رئيس لجنة الهجرة في أمريكا ان يوقف إجراء بطرد طبيبة عربية لم يستطع المحامي ان يفعل لها شي قبل ان يسألها يائسا أتعرفين أستاذا في الجامعة يمكن ان يقدم شهادة لصالحك اما في بلادنا فكان سيسألها اتعرفين ظابطا كبيرا ام وزيرا او أي زعيم يتوسط لك عند القضاء ولكن في امريكا كل هؤلاء لا يضاهون وجاهة الاستاذ ولا هيبته البيت الابيض لايثير في نفسك شيئا مما توقعت من انبهار وانت ترى حديقته المفتوحة على الطريق وداخلها عدد من السياح الفضوليين ولكن هذا المشهد بالذات هو الذي سيوقظ المك ويذكرك بتلك القصور المسيجة لحكام لايمكن الاقتراب من بيوتهم بالعين المجردة |
||||||

|
|
|
#16 | ||||||
|
مشرف
|
ابني.. الإيطالي انتهى حديثي عن رومــــا، عند ذلك السائق الذي تشاطر عليّ وأقنعني بأنني أمددته بورقة نقدية من فئة العشرة يورو·· لا الخمسين، وتقاضى مني بالتالي مئة يورو، عن مشوار المطار الذي يساوي نصف ما دفعت· ولم يحزنِّي الأمر كثيراً، مادام هذا كلّ ما فقدت، مقارنة بنسيبي، الذي على فائق ذكائه وشطارته، وتردده على إيطاليا أكثر من مرَّة، نجح الطليان في ميلانــو في سرقة حقيبة يده، بكل محتوياتها من مبالغ نقدية وجوازات سفر وبطاقات مصرفية، بعد أن قاموا بتنفيس دولاب سيارته، وسطوا على محتوياتها أثناء توقُّفه للبحث عمَّن يساعده· وهكذا تحوّلت لديه مقولة “روما فيدولتا فيدا بردوتا” أي “شاهد روما وافقد إيمانك” إلى “شاهد روما وافقد جزدانك” (أي حقيبة يدك)· ابني غسان، الذي جاء من لندن، حيث يتابع دراسته في إدارة الأعمال، التحق بي كي يراني ويكتشف روما، أخيــــراً، بعدما قضى الصيف الماضي في إيهام بنات “كان” بأنه إيطالي، حتى إنه اختار اسماً “حركياً” لغزواته العاطفية، بعد أن وجد أنّ البنات يقصدنه لذلك السبب· فالرجل الإيطالي له سطوة لدى الفرنسيات بحُكم صيته العشقي، وأناقته المتميزة· ولا داعي لتخييب ظن البنات مادام الأمر لا يتعدَّى سهرة في مرقص· وعبثاً حاولت مناقشة الموضوع معه، وإقناعه بأن “حبل الكذب قصير”، فكان يردُّ بأن البنات هنّ مَن يفضّلن سماع الأكاذيب· وانتهى بي الأمر إلى الاقتناع بقول عمر بن الخطاب (رضي اللّه تعالى عنه) “لا تخلِّقوا أولادكم بأخلاقكم، فقد خُلِقوا لزمان غير زمانكم”، خاصة أنني عجزت أيضاً عن إقناعه بالوفاء لصديقة واحدة، ودفعت ثمن تعدُّد صديقاته، عندما كان عليَّ في روما أن أشتري هدايا لهن جميعاً، وأتشاور معه طويلاً في مقاساتهن وأذواقهن، وأجوب المحال النسائية بزهد كاتبة، بعد أن جبت المحال الرجالية بصبر أُمٍّ، لأشتري له جهازاً يليق بوظيفة في النهار في بنك إنجليزي، ووظيفة ليلاً كعاشق إيطالي· وقد حدث في الصيف أن أشفقت كثيراً على إحدى صديقاته، الوحيدة التي عرّفني إليها، والتي تقدَّم إليها باسمه الحقيقي، نظراً إلى كون علاقتهما دامت شهرين· وكانت المسكينة تدخل في شجارات مع والدها، المنتمي إلى الحزب اليميني المتطرِّف الذي يشهر كراهيته للعرب، وتستميت في الدفاع عمّا تعتقده حبّاً· وذهبتْ حتى شراء نسخة من “ذاكرة الجسد” بالفرنسية لإطلاع أهلها على أهمية “حماتها”، وكانت تملأ البيت وروداً كلّما سافرت وتركت لهما الشقة، وتُهاتفني سراً لتسألني إن كان ابني يحبّها حقاً· ووجدتني مرغمة على الكذب عليها· وتأكيداً لأكاذيبي، صرت أشتري لها هدايا كي يقدِّمها لها ابني، بما في ذلك هدية وداعٍ، عندما غادر غسان “كان” إلى لندن· فالمسكينة لم تكن قد سمعت بمقولة مرغريت دوراس: “في كلِّ رجل ينام مظلِّي”· ولم تكن تدري أنّ الرجال دائماً على أهبة رحيل نحو حبّ آخر· ربما من وقتها أضفت إلى واجبات أُمومتي، واجب شراء هدايا لصديقات ابني، وإلى مشاغلي الروائية·· مهمّة إسعاد بطلة حقيقية، تشبهني في شغفي وذعري وشكّي وسخائي·· و غبائي العاطفي· بعد عودته إلى لندن، هاتفني غسان مبتهجاً· قال: “شكراً ماما·· كانت الإقامة معكِ جميلة في روما·· الثياب التي اشتريتها لي أعجبت الجميع·· وصديقاتي هنا جميعهن سعيدات بالهدايا”· ثم أضاف مازحاً: “جاهز أنا لأراكِ في أيّة مدينة تسافرين إليها”· غسان عمره 23 سنة· التهم من كتب الأدب والفلسفة أكثر مما قرأت أنا· |
||||||

|
|
|
#17 | ||||||
|
شبه عضو
-- أخ لهلوب --
|
اووووووووو مجهود رااااااائع butterfly دايما صاحبة المجهودات الرائعة شكرا على المقالات، كتير لكن مادامت للكاتبة احلام مستغانمى يبقى لازم تتقرى شكرا لك 
يارفيق الدرب تاه الدربُ منى ...رغم هذا سأغنى..
فأنا بالشِعر أحيا كالغدير ِ المطمئنِّ... إنما الشعر حياتى..وخلودى...والتمنى ----------------------------------- على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ماشاء أنا مـــــصـــــر عندى أحب وأجمل الأشياء |
||||||

|
|
|
#18 | ||||||
|
عضو
-- قبضاي --
|
شكرا شكرا جداً جزيلا !!
إنني أرفض اختيار طريق ،، لأنه يقيدني
أفضل البقاء في مفترق الطرق .. أنني أعاني الحرية ولا أمارسها !! CHE* |
||||||

|
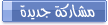
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 14:36 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)






