
|
| س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | بحبشة و نكوشة | مواضيع اليوم | أشرلي عالشغلات يلي قريانينها |
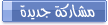
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
 "عاموس عوز" أديب إسرائيلى ومن كبار الأدباء العبريين فى عصرنا الحالى. ولد الأديب "عاموس عوز" فى القدس عام 1939 وكان اسمه آنذاك "عاموس كلاوزنر" لأسرة مثقفة حيث كان عم والده "يوسف كلاوزنر" رئيس قسم الأدب العبرى بالجامعة العبرية بالقدس . وعلى الرغم من أسرته كانت بعيدة عن الدين درس "عوز" فى مدرسة "תחכמוני- تحكمونى" الدينية العامة لأن البديل هو الدراسة فى مدرسة أبناء العمال ذات الطابع الاشتراكى الذى كان والده يعارضه بشدة . فى المرحلة الثانوية التحق "عوز" بمدرسة "רחביה– رحافيا" العبرية . وعندما بلغ من العمر 15 عامًا غادر "عوز" بيت أبيه وانضم لكيبوتس "חולדה- حولده" وعاش فيه كأى عضو كيبوتس . توزج من "נילי - نيلى" وأنجبا ثلاثة أطفال . وبعد سنوات عديدة انتقل لٌلإقامة فى "عاراد" بسبب مرض ابنه . درس فى الجامعة العبرية الأدب والفلسفة وتخرج فيها عام 1964 . حصل "عوز" على الماجستير فى جامعة أكسفورد عام 1970 .بدأ "عوز" فى نشر إنتاجه الأدبى وهو يبلغ من العمر 22 سنة حيث نشر مجموعة قصصية قصيرة بعنوان "ארצות התן - بلاد ابن آوى" عام 1965 ، كما صدرت أول روايه له فى عام 1966 بعنوان "מקום אחר– مكان آخر" ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن الكتابة ، ويصدر له رواية كل عام تقريباً . ترك "عوز" دار نشر " עם עובד – عم عوفيد" على الرغم من انتمائها السياسى وتعاقد مع "כתר– كيتر" حيث ضمنت له دار النشر راتباً شهرياً ثابتاً بصرف النظر عن حجم إنتاجه الأدبى . حصل "عوز" على جوائز عديدة من أهمها جائزة "جوته" التى تعد ثانى جائزة فى أوروبا بعد جائزة نوبل وذلك فى عام 2005 ، وفى مطلع العام 2006 منحته الجامعة العبرية بالقدس درجة الدكتوراة الفخرية فى الفلسفة تقديراً لإسهاماته الأدبية والاجتماعي
شُذَّ، شُذَّ بكل قواك عن القاعدة
لا تضع نجمتين على لفظة واحدة وضع الهامشيّ إلى جانب الجوهريّ لتكتمل النشوة الصاعدة |

|
|
|
#2 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
قصة عن الحب والظلام ترجمة: جميل غنايم مراجعة: محمود كيّال עמוסעוז: סיפורעלאהבהוחושך Amos Oz: A TALE OF LOVE AND DARKNESS 1 ولدت وترعرعت في بيت أرضي صغير جدًًّا، لا تتجاوز مساحته الثلاثين مترا مربعا، يكاد سقفه يلامس رؤوس ساكنيه، كان سرير نوم والديّ عبارة عن كنبة دُرج كانت تفتح مساء كلّ يوم فتملأ الغرفة من الحائط إلى الحائط. وفي الصباح الباكر كانا يطويانها ويخفيان في أحشاء درجها السفلي الشراشف والمخدات ويكسوانها بغطاء رمادي فاتح وينثران عليها وسائد شرقية مطرّزة، حتى لا يبقيا أثرًا لنوم ليلتهما عليها. وهكذا كانت غرفتهما غرفة نوم وغرفة عمل ومكتبة وغرفة طعام وغرفة ضيوف. مقابل هذه الغرفة كانت غُريفتي الخضراء، التي احتلت نصف مساحتها خزانة ملابس ضخمة الكرش. كان يربط هاتين الغرفتين الصغيرتين بالمطبخ وكوخ المنافع ممرٌ مظلم وضيق ومنخفض وملتوٍ بعض الشيء يشبه سرداب الهاربين من سجن. مصباح كهربائي ضعيف محبوس داخل قفص حديديّ كان يلقي بضوئه الباهت المتكدّر على هذا الممر في ساعات النهار أيضًا. من الجهة الأمامية لم يكن هناك إلا شباك واحد لغرفة والديّ وشباك واحد لغرفتي، كلاهما محميان بدُرَف حديدية، وكلاهما يحاولان أن يسترقا النظر ليُطلا شرقا إلا أنهما لا يريان إلا شجرة سرو مغبرة وجدارًا من حجارة غير مصقولة. أطلّ مطبخنا ومنافعنا عبر كوّة محدّدة على ساحة سجناء صغيرة محاطة بحيطان عالية ومرصوفة بالأسمنت، فيها كانت تحتضر نبتة خبيزة شاحبة زرعت في صفيحة زيت صدِئة لعدم وصول أشعة الشمس إليها. على قواعد النوافذ كانت تصطف دائمًا مرطبانات مغلقة فيها خيار مخلل وشتلة صبّار مغمومة البال مستحكمة في تراب مزهرية تشقّقت فتحوّلت للخدمة بوظيفة أصيص. كان ذلك بيت أرضيّ: الطابق الأرضي في هذا المبنى حفر في سفح جبل. كان هذا الجبل هو جارنا الذي خلف الحائط - جار ثقيل، انطوائيّ، واجم ، جبل هرم وكئيب، له عادات أعزب ثابتة، حرص دائمًا على الهدوء المطلق، جبل وسنان كهذا، شتويّ، لم يسبق أن حرّك أثاثًا أو استقبل ضيوفا لم يضايق ولم يضجّ أو يشكُ. ولكن عبر الحائطين المشتركين بيننا وبينه كانت تتسرّب إلينا دائمًا برودة وظلمة وصمت ورطوبة هذا الجار المكتئب مثل رائحة العفونة الخفيفة والعنيدة. وهكذا كان طوال فترة الصيف يُحتفظ عندنا شيء من الشتاء. كان الضيوف يقولون: لطيف جدًًّا عندكم في أيام الحر الشديد، بارد وهادئ، بارد فعلا، ولكن كيف تتحملون ذلك في الشتاء؟ أولا تنقل الحيطان الرطوبة؟ أوليس الوضع كئيبا في الشتاء هنا؟ * الغرفتان، كوخ المطبخ، المنافع وخاصة الممر الذي بينها كانت كلها مظلمة. الكتب عندنا ملأت كلّ زاوية في البيت: عرف والدي القراءة بست عشرة أو سبع عشرة لغة والتحدّث بإحدى عشرة (وكلها بلكنة روسية). أمي تحدثت بأربع أو خمس لغات وقرأت بسبعٍ أو ثمانٍ. كانا يتحدثان بينهما بالروسية والبولندية عندما أرادا ألا أفهم (طوال الوقت أرادا ألا أفهم، عندما زلّ لسان امي مرة وقالت على مسمع مني "حصان فَحل" باللغة العبرية بدلا من الأجنبية، أنّبها والدي بلغة روسية غاضبة: شتو اسْ تبوي؟! فيدش مَلتشيك ريادوم اسْ نامي!). لاعتبارات حضارية قرأ والديّ كتبا بالألمانية والإنجليزية بشكل خاصّ، أما أحلامهما في الليل فقد كانت بالتأكيد بالإيديش. أما أنا فلم يعلماني إلا العبرية لا غير: ربما خشيا من أن معرفة اللغات ربما تكشف لي مغريات أوروبا الرائعة والقاتلة. في سلم قيم والديّ، كلّ ما كان غربيا أكثر اعتبروه أكثر تحضّراً: تولستوي ودوستويفسكي كانا قريبين إلى نفسيهما الروسيتين، ومع ذلك، يخيّل إليّ أن ألمانيا – بالرغم من هتلر- كانت في نظرهما أكثر تحضّراً من روسيا وبولندا؛ وفرنسا- أكثر من ألمانيا. بريطانيا احتلت في نظرهما مكانة أعلى حتى من فرنسا. أما بالنسبة لأمريكا- لم يعودا على يقين: هناك يطلقون النار على الهنود الحمر ويسطون على قطارات البريد، يحققون أرباحاً خيالية ويصطادون البنات. كانت أوروبا بالنسبة إليهما بلاد الميعاد المحرّمة، بلاد الحنين والأشواق، وأبراج الأجراس والميادين المرصوفة ببلاط حجري عتيق. بلاد الترام والجسور وأبراج الكنائس، القرى النائية، والينابيع الطبية، والغابات والثلوج والمراعي. الكلمات " كوخ"، "مرعى"، "راعية الإوزّ" كانت تغريني وتثير انفعالي طوال فترة طفولتي. فقد كانت تحمل نكهة حسية لعالم حقيقيّ، مطمئن، بعيد عن أسطح الصفيح المغبرة، وساحات الخردوات والأشواك وعن سفوح القدس القاحلة التي تختنق تحت وطأة الصيف المتوهّج. كان يكفي أن أهمس لنفسي "مرعى" حتى أسمع خوار البقرات التي عُلّقت أجراس صغيرة في أعناقها وخرير الغدران. كنت أنظر إلى راعية الإوز الحافية بعينين مغمضتين، والتي كانت في نظري مثيرة، بلا حدود، للشهوة الجنسية قبل أن أعي شيئا. * بعد مرور سنوات تبيّن لي أن القدس التي تحت الحكم البريطاني في سنوات العشرين والثلاثين والأربعين، كانت مدينة ثقافية جذابة: كان فيها تجار كبار، وموسيقيون، ومثقفون وأدباء: مارتين بوبر وجرشوم شالوم وعَجنون بالإضافة إلى كثير من الباحثين والفنانين المرموقين. أحيانًا، عندما كانوا يمرون في شارع بِن يهودا أو في جادّة بن ميمون كان أبي يهمس في أذني: "ها هو هناك يمر مثقف صاحب شهرة عالمية". لم أعِ ما كان يرمي إليه. ظننت أن للشهرة العالمية علاقة بمرض في الرِّجلين، وذلك لأنّه، في معظم الحالات، كان ذلك شخصا هرما يتوكأ على عصا تتلمّس له الطريق ورجلاه تتثاقلان، وهو، إلى ذلك، يرتدي في الصيف بذلة صوف ثقيلة. القدس التي كانت محطّ أنظار والديّ امتدّت بعيدا عن حيّنا: كانت القدس في حي رحافيا المغمورة بالخضرة وبأنغام البيانوهات، كانت في ثلاثة إلى أربعة مقاهٍ ذات ثُريّات مُذهبة في شارع يافا وشارع بِن يِهودا وفي قاعات الواي أم سي إي (جمعية الشبان المسيحيين)، وفي فندق الملك داوود. هناك كان يجتمع محبو الثقافة من اليهود والعرب مع بريطانيين مثقفين ولطفاء، هناك أبحرت – حلّقت سيدات حالمات طويلات العنق بفساتين السهرة وهن يمسكن بأذرع سادة يرتدون البدلات الغامقة (السوداء)، هناك جلس انجليز واسعو الاطلاع والمعرفة مع يهود حضاريين ومع عرب مثقفين، هناك أقيمت الحفلات الموسيقية الفردية، والحفلات، والأمسيات الأدبية، وحفلات الشاي، والمناقشات الفنية الرقيقة. إلا أن قدسا كهذه، مع ثريات وحفلات شاي لم تكن إلا في أحلام سكان "كيرم أفراهام"، أمناء مكتبات، معلمين، موظّفين ومُجلّدي كتب. على كلّ لم تكن عندنا؛ حيّنا كيرِم أَفراهام كان تابعا لتشيخوف. بعد سنوات، عندما قرأت تشيخوف (مترجما إلى العبرية) كنت متأكّدا أنه واحد منّا: فها هو العمّ فانيا يسكن، فعلا، في الطابق الذي فوقنا، والدكتور سامويلنكو كان ينحني ويجسّ جسمي بيديه العريضتين والقويتين عندما مرضت بالذبحة الصدرية أو بالخانوق (الدِّفتيريا)، لايبسكي صاحب الصُّداع النّصفي المزمن كان ابن عم امي، أما تريغورين فكنا نذهب للاستماع إليه في صباح السبت في قاعة "بيت الشعب". صحيح أنه كان عندنا أشخاص روس من أصناف مختلفة: كان الكثير من التولستويين، حتى أن بعضهم كان يشبه تولستوي شبها تامّا. عندما اصطدمت بصورة بُنيّة لتولستوي على غلاف كتاب، كنت متأكّدا أنني رأيته عندنا مرارا كثيرة: يتسكع في شارع ملآخي أو في منحدر شارع عوفاديا حاسر الرأس، ولحيته الشائبة تتطاير في الهواء، كله هيبة ووقار مثل سيدنا إبراهيم الخليل، عيناه يتألق وميضهما، وبيده غصن يتخذه عكازا، وقميصه الفلاحي يتدلّى فوق بنطلونه الواسع الفضفاض، مربوط بحبل غليظ حول خصره. التولستويون في حيّنا (والداي كانا يسميانهم " تولستويتشيكيين" ) كانوا جميعا نباتيين غيورين، مُصلحين، دُعاة أخلاق، يملأهم إحساس عميق نحو الطبيعة، يحبون البشر، ويحبون كلّ مخلوق حيّ، أيّ مخلوق، يملأهم حماس للسلام ومعارضة للحرب والشوق الشديد إلى حياة العمل البسيطة والنقيّة، وكلهم توّاقون إلى حياة الريف، والعمل الزراعي الأصيل في أحضان الحقول والبساتين. ولكنهم مع ذلك لم يفلحوا كثيرا حتى في العناية بأصصهم المتواضعة: ربما سقوا النباتات كثيرا حتى ماتت غرقًا أو ربما فاتهم أن يسقوها فماتت عطشا، أو ربما كانت تلك مسؤولية الحكم البريطاني الذي كان يمزج الكلور بمياهنا. قسم منهم كانوا تولستويين شديدي الشبه بشخصيات رواية لدوستويفسكي معذّبين، كثيري الكلام، غرائزهم مكبوتة، وآراؤهم مترددة. ولكن جميعهم، التولستويين وكذلك الدوستويفسكيين، كلهم في حي "كيرِم أَفْراهام" كانوا في الواقع يشتغلون عند تشيخوف. بشكل عام، كلّ العالم كان يسمّى عندنا باسم "العالم الكبير"، مع أنه إضافة إلى ذلك كانت له أسماء عائلة أخرى: المتنور، الخارجي، الحر، المنافق. أما أنا فلم أتعرف عليه تقريبا إلا من مجموعة الطوابع: دنتسيك. بوهيميا ومورافيا. البوسنة والهرسك. أوبنجي- شاري. ترينيداد وطوبغو. كينيا- أوغندا- تنغانيكا. كلّ العالم كان بعيدا، جذابا، فتنا ولكن خطيرا جدًًّا ومعاديا لنا: لا يحبون اليهود لأنهم فطِنون، متوقدو الذهن ومتفوقون وإلى جانب ذلك ضوضائيون ويقفزون في المقدمة. ولا يحبون مشروعنا هنا في أرض إسرائيل لأنهم يحسدوننا حتى على قطعة أرض صغيرة كلها مستنقعات وصخور وصحاري. هناك في العالم جميع الحيطان كانت مغطاة بالكتابات المعادية: "أيها اليهودي الحقير، اذهب إلى فلسطين، "وها قد ذهبنا إلى فلسطين والآن كلّ العالم يصرخ علينا: "أيها اليهودي الحقير، اخرج من فلسطين." ليس كلّ العالم وحده كان بعيدا بل أرض إسرائيل أيضًا: هناك في مكان ما، وراء الجبال، أخذ ينمو جنس جديد من اليهود الأبطال، جنس مسفوع، قويّ، سكوت وعمليّ، لا يشبه إطلاقا اليهودي المهجري ولا يشبه إطلاقا سكان كيرم افراهام. فتيان وفتيات، طلائعيون، حازمون، مسفوعون، سكوتون، والذين افلحوا في تحويل ظلمة الليل إلى صديق؛ كما أنهم فيما يتعلق بعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات النساء بالرجال قد قطعوا شوطا واجتازوا كلّ القيود ولم يعودوا يخجلون من أي شيء. ذات مرة قال لي جدّي ألِكْسَنْدِر: "إنهم يعتقدون أن الأمر في المستقبل سيكون سهلا جدًًّا، حيث يستطيع الشاب التقدم من الفتاة ويطلب منها ذلك، وربما لن تنتظر الفتيات حتى يطلب الشاب منهن ذلك وربما طلبن هن أنفسهن ذلك من الشباب كما يطلبون أن يصبوا لك كأس ماء." أما العمّ بتسليئل قصير النظر فقد قال غاضبا ولكن بأدب: "ولكن أوليس هذا أمرا بولشِفيًّا من الدرجة الأولى، أن يُهدم كلّ سرية وتكتّم؟! أن تلغى كلّ العواطف والمشاعر؟! أن تحوَّل كلّ حياتنا إلى كأس ماء فاتر؟!" أما العمّ نحميا فكان، من زاويته، يخور فجأة ببيتين من الشعر بدوا لي مثل أنين حيوان يائس: "أواه، تبدو لي الطريق بعيدة جدًًّا، الدرب يتلوّى ويهـرب، أواه يا أماه، أنا اهتزّ ولكنك بعيدة، القمر أقرب إليّ منك..." والعمّة تسيبورة تقول بالروسية: "هيا، كفى، هل جننتم جميعا؟ أوليس الولد يسمعكم!" وعندها ينتقلون إلى الروسية. |

|
|
|
#3 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
أولئك الطلائعيون عاشوا وراء أفقنا، في الجليل، وفي الشارون وفي المرج (ابن عامر). شباب أقوياء، حميمو الفؤاد ولكنهم سكوتون مستغرقون في التفكير، وفتيات ممتلئات الجسم، صريحات، متمالكات النفس، كأنهن يعرفن كلّ شيء ويفهمن كلّ شيء، يعرفنك أيضًا ويعرفن كلّ ارتباكاتك، وبالرغم من ذلك فهن يتصرفن معك بلطف وجدّية واحترام، ليس كما مع الأولاد بل مثل رجل ككل الرجال ولكنه ما زال قصير القامة.
بدا هؤلاء الطلائعيون والطلائعيات أقوياء، جدّيين، يحفظون السرّ، قادرين على الغناء في حلقة أغاني الحنين والأشواق التي تقطع القلب وكذلك أغاني الدعابة والهزل وأغاني الشهوة الجريئة إلى حد الفزع الذي يتجاوز حدود الحياء، قادرون على عاصفة من الرقص الجارف حتى النّشوة، قادرون على الانزواء والتأمل، على حياة الميدان والخيام، وعلى كلّ عمل صعب، "نحن رهن الإشارة دائمًا"، "حمل إليك أبناؤك سلام – المحراث، واليوم يحملون إليك السلام على البنـــاد- ق!"، "حيثما نُرسَل – إلى هناك نتوجّه"، قادرون على ركوب الخيول غير الأليفة، والجرّارات ذات الجنازير العريضة، يعرفون العربية، يعرفون المغاور والأودية والمسدسات والقنابل اليدوية، وإلى جانب كلّ ذلك، يقرؤون الشعر وكتب المطالعة، واسعو الاطلاع، يكتمون مشاعرهم، يتحادثون أحيانًا فيما بينهم بصوت منخفض جدًًّا على ضوء شمعة في خيمتهم في الهزيع الأخير من الليل حول معنى الحياة وعن الاختيار الشهيّ بين الحبّ والواجب وبين الحاجة القومية وبين الحقّ. أحيانًا كنت أذهب مع أصدقاء إلى ساحة تنوفا حيث تفرّغ الشاحنات حمولتها، كي أنظر إليهم قادمين من وراء جبال الظلام على ظهر شاحنة محمّلة بالمنتجات الزراعية، "يلبسون الملابس العادية والنطاق والأحذية الثقيلة"، كنت أدور حولهم كي أشمّ رائحة القشّ وانتشي بروائح المسافات: هناك، عندهم، تحدث الأمور الكبيرة بالفعل. هناك يبنون البلاد ويصلحون العالم، وينشئون مجتمعا جديدا، يتركون أثرهم على الأرض وعلى التاريخ، هناك يحرثون الحقول ويغرسون الكروم، هناك يؤلفون شعرا حديثا، هناك يركبون مدججين على ظهر الفرس ويردون بالنار على نيران الثوّار العرب، هناك يأخذون الرعاع التافهين ويصنعون منهم شعبا مقاتلا. حلمت سرا بأنهم يأخذونني أيضًا إليهم في أحد الأيام. كي يحوّلوني أيضًا إلى شعب مقاتل. كي تتحول حياتي أيضًا إلى شعر حديث، حياة نقية، مستقيمة وبسيطة مثل كأس ماء بارد في يوم حار. |

|
|
|
#4 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
تل أبيب في تلك الأيام كانت خلف جبال الظلام أيضًا، مكان مثير جاءتنا منه الصحف، والإشاعات حول مسرح وأوبرا وباليه وكباريه وعن فن حديث، الأحزاب، صدى النقاشات العاصفة، وكذلك بعض الأقاويل الغامضة. رياضيون كبار كانوا هناك في تل أبيب. وكان هناك بحر، والبحر هناك كله مملوء باليهود المسفوعين الذين يجيدون السباحة. من يجيد السباحة في القدس؟ مَن، أصلا، سمع مرة عن يهود يسبحون؟ هؤلاء هم من طينة أخرى. طفرة. "كأعجوبة ولادة الفراشة من الدودة."
كلمة "تل أبيب" وحدها كان لها سحر خفي خاصّ. عندما يقال "تل أبيب" كنت أرى في الخيال للتوّ صورة شاب قوي كهذا، بفانيلا الشغل الزرقاء، مسفوع، عريض المنكبين، شاعر-عامل- ثوريّ، شاب لا يعرف الخوف، اعتبروه "سهل المعاشرة"، مجعّد الشعر، يعتمر قبعة "كاسكت" بإهمال- وتأنّق، يدخن سجائر "ماتوسيان" وهو "محلّيّ" في هذا العالم: يعمل طوال النهار في التبليط أو الأسمنت، وفي المساء يعزف على الكمان، وفي الليل يرقص مع الفتيات أو يغني لهنّ أغاني حزينة بين الرمال على ضوء البدر، وقبيل الفجر يسحب من مخبئه مسدسا أو رشّاشا ويخرج خلسة في قلب الظلام ليحمي الحقول والبيوت. كم كانت تل أبيب بعيدة! طوال سنوات طفولتي كنت في تل أبيب خمس أو ست مرات لا أكثر: كنا نسافر لقضاء العيد مع الخالات. ليس الضوء وحده في تل أبيب في ذلك الوقت كان مختلفا عن الضوء المقدسي أكثر مما هو مختلف عنه الآن، بل حتى قوانين الجاذبية كانت مختلفة تماما. ففي تل أبيب مشوا بشكل مختلف: قفزوا- حلقوا، كما فعل نيل آرمسترونج على القمر. أما عندنا في القدس فكانوا يمشون دائمًا كمن يمشون في جنازة، أو كمن يدخلون متأخرين إلى كونسرت: أولا يضعون طرف الحذاء ويتذوقون بحذر الأرض. بعد ذلك عندما يكونون قد وضعوا القدم لا يسرعون في تحريكها: بعد ألفي سنة وجدوا موقع قدم في القدس، إذن لن يتنازلوا عنها بهذه السرعة. إذا رفعنا القدم – فورًا سيأتي شخص آخر ويأخذ منا قطعة أرضنا، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. من جهة أخرى، إذا كنت قد رفعت رجلك – لا تسرع وتعود إلى وضعها: من يدري أي شِلّة أفاعٍ، معادية، تحيك المؤامرات، يمكن أنها تحطّ هناك. أولم ندفع خلال آلاف السنين ثمنا من الدماء مقابل تسرّعنا، المرة تلو المرة وقعنا في أيدي عدو وخصم لأننا وضعنا أقدامنا دون أن نفحص أين. هكذا تقريبا كان المشي المقدسيّ. ولكن في تل أبيب، ما هذا! المدينة كلها كانت جندبا. تدفّق الناس وتدفّقت البيوت والشوارع والميادين ورياح البحر والرمال والجادات وحتى السحب في السماء. في إحدى المرات جئنا إلى تل أبيب للاحتفال بليلة عيد الفصح، وفي الصباح الباكر عندما كان الجميع ما زالوا نياما لبست ملابسي وخرجت من البيت ورحت لألعب وحدي في ساحة ما صغيرة وفيها مقعد أو مقعدان، أرجوحة، وصندوق رمل، وثلاث – أربع شجرات صغيرة كانت العصافير التي عليها قد بدأت تزقزق. بعد ذلك بعدة أشهر، في رأس السنة، سافرنا مرة أخرى إلى تل أبيب، وإذا الساحة قد اختفت. نقلوها بأشجارها الصغيرة والأرجوحة والمقعد والعصافير وصندوق الرمل إلى طرف الشارع الآخر. ذهلت: لم افهم كيف يسمح بن غوريون والمؤسسات المسؤولة بالقيام بمثل هذا العمل. كيف ذلك؟ من يقوم فجأة بنقل ساحة؟ ما هذا، غدا يمكن أن ينقلوا جبل الزيتون؟ برج داوود؟ حائط المبكى؟ كانوا عندنا يتحدثون عن تل أبيب بحسد وافتخار، وتقدير وبنوع من السرية: كأنّ تل أبيب هي نوع من مشاريع الشعب اليهودي السرية والحيوية، مشروع من المفضل عدم التحدّث عنه أكثر من اللازم، للحيطان آذان، المبغضون وعملاء الأعداء موجودون في كلّ مكان. تل أبيب: بحر، ضوء، سماء زرقاء، رمال، سِقالات، يهود، أكشاك في الجادّات، مدينة عبرية بيضاء، بسيطة الخط، تنمو بين البيارات والكثبان. ليست مجرد مكان تشتري تذكرة وتسافر إليه في حافلة شركة "إيجد" بل قارة أخرى. * |

|
|
|
#5 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
طوال سنتين كان لنا ترتيب ثابت للاتصال التلفوني مع العائلة في تل أبيب. مرة كلّ ثلاثة- أربعة أشهر كنا نتصل بهم تلفونيا، مع أنه لم يكن عندنا ولا عندهم تلفون. في البداية كنا نرسل رسالة إلى الخالة حاية والعمّ تسفي وفيها نكتب أنه في التاسع عشر من الشهر الذي يوافق يوم الأربعاء، في أيام الأربعاء تسفي ينهي العمل في عيادة صندوق المرضى (كوبات حوليم) في الساعة الثالثة، وعليه، في الساعة الخامسة نتصل بهم من صيدليتنا إلى صيدليتكم. ترسل الرسالة قبل اليوم الموعود بوقت طويل وكنا ننتظر منهم الردّ. في ردّهم يعد العمّ تسفي والخالة حاية بأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر ملائم لهما تماما وأنهما سينتظران في الصيدلية قبل الساعة الخامسة، وألا نقلق إذا حدث واتصلنا بعد الخامسة بقليل إذ أنهما لن يهربا بكل تأكيد.
أنا لا اذكر إذا كنا نلبس أجمل ملابسنا بمناسبة الذهاب إلى الصيدلية، تكريما للمكالمة مع تل أبيب، لكنني لن استغرب إذا كنا نفعل ذلك. كان ذلك طقس احتفالي. فمنذ يوم الأحد كان أبي يقول لأمّي: فانيا، هل تذكرين هذا الأسبوع هو أسبوع المكالمة مع تل أبيب؟ وفي يوم الاثنين كانت أمي تقول: آرييه، لا تتأخر بعد غدٍ حتى لا يحدث أي طارئ. وفي يوم الاثنين كان كلاهما يقولان لي، عاموس، إيّاك أن تعمل لنا أي مفاجأة، هل تسمع، احترس من أن تصاب بمرض ، أو زكام، أو أن تقع حتى غد بعد الظهر. وفي الليلة الأخيرة كانا يقولان لي: اذهب للنوم مبكرا حتى تكون قويا غدا في التلفون، أنا لا أريدهم أن يسمعوك هناك كمن لم يتغذّ. هكذا كانا يبنيان الانفعال. كنا نسكن في شارع عاموس، والصيدلية كانت على بعد خمس دقائق مشيا على الأقدام، في شارع تسفانيا، ولكن أبي كان منذ الثالثة يقول: "لا تبدئي بأي شيء جديد الآن، حتى لا تكوني في ضيق من الوقت." "أنا على أتمّ الاستعداد، ولكن أنت مع كلّ هذه الكتب، أخشى أن تنسى الأمر كليا." "أنا؟ أنسى؟ إنني أنظر في الساعة كلّ عدة لحظات وعاموس يذكّرني." ها أنا في الخامسة أو السادسة وأتحمل مسؤولية تاريخية، ما كانت لي ساعة يدوية ولم يكن بالإمكان أن تكون لي ولذلك كنت اركض كلّ لحظة إلى المطبخ لأرى ماذا يقول المنبّه، وكمن يطلق سفينة فضاء كنت أعلن: بعد خمس وعشرين دقيقة، بعد عشرين، بعد خمس عشرة، بعد عشر دقائق ونصف- وعندما كنت أقول بعد عشر دقائق ونصف كنا نقف نغلق البيت جيدا ونخرج ثلاثتنا إلى الشارع إلى اليسار حتى نصل بقالة السيّد أوستر ثمّ نتجه إلى اليمين إلى شارع زخاريا وشمالا إلى شارع ملآخي ويمينا إلى شارع تسفانيا ومباشرة كنا ندخل إلى الصيدلية، نقول: "السلام والتحية سيد هاينمن، كيف حالك؟ جئنا من أجل التلفون." إنه على علم، بالطبع، بأننا سنأتي يوم الأربعاء لكي نتصل بأقاربنا في تل أبيب، كما أنه يعلم بأن تسفي يعمل في عيادة، وأن لحاية كانت وظيفة مرموقة في مجلس العاملات وبان يجئال سيكبر ويصبح رياضيا وبأنهم أصدقاء مقربون لجولدا مئيرسون وميشا كولودني، المعروف هنا باسم موشيه كول، ولكننا مع ذلك ذكّرناه: "جئنا كي نتّصل بأقاربنا في تل أبيب." كان السيّد هاينمن يقول: "نعم، بالطبع. تفضلوا بالجلوس،" وكان يحكي لنا نكتة التلفون الدائمة: ذات مرة في المؤتمر الصهيوني في زوريخ انفجر فجأة صراخ فظيع من إحدى الغرف الجانبية. سأل بيرل لوكر هرتسفيلد: ما هذا الصراخ؟ فأجابه هرتسفيلد بأن هذا هو الرفيق روبشوف يتحدث في التلفون مع بن غوريون في القدس. يتكلم مع القدس! استغرب بيرل لوكر، إذن لماذا يستعمل التلفون؟ كان أبي يقول: "الآن سأطلب الرقم." وأمي: "ما زال الوقت مبكرا، آرييه. بقيت عدة دقائق حتى يحين الوقت." فكان يقول: "نعم، ولكن حتى يتم الاتصال (لم يكن في حينه اتصال مباشر). فتقول أمّي: "ولكن ما يحدث لو أن الاتصال تمّ بسرعة، وهم لم يصلوا بعد؟" وكان أبي يجيبها: "في مثل هذه الحالة نعاود الاتصال مرة ثانية." فتقول أمي: "لا، فهم سيقلقون، فقد يظنون أنهم خسروا المكالمة." وما أن ينتهي الجدّال بينهما حتى تصبح الساعة الخامسة تقريبا. كان أبي يرفع السماعة، وهو واقف لا جالس، وكان يقول لعاملة المقسم: "تحياتي لك يا سيدتي. أطلب تل أبيب 648" (أو شيئا من هذا القبيل. في حينه عشنا عهد الأرقام الثلاثة). في بعض الأحيان كانت عاملة المقسم تقول: "رجاء الانتظار بضع لحظات، أيها السيّد، فإنّ مدير البريد يتحدث الآن." أو السيّد سيطون أو السيّد النشاشيبي. أما نحن فكنا نشعر بالضيق شيئا ما، إذ ماذا سيحدث؟ ماذا سيظنون بنا هناك؟ استطعت فعلا أن أرى ذلك السلك الوحيد الذي يربط القدس بتل أبيب وعبرها - بكل العالم، وهذا الخط مشغول، وما دام هذا الخط مشغولا – فنحن مقطوعون عن العالم. هذا السلك يلتوي في الصحراء وفوق الصخور يتلوى بين الجبال والتلال وقد اعتقدت أن هذه معجزة كبيرة. وقد ارتعدت فرائصي: ماذا سيحدث لو أن بعض الحيوانات الضارة جاءت في الليل وأكلت هذا السلك؟ أو قام عربي شرير بقطعه؟ أو تتسرب إليه مياه الأمطار؟ أو يحدث حريق في الأشواك؟ من يدري. كانت تملؤني مشاعر الشكر لأولئك الأشخاص الذين قاموا بمد هذا الخط، شجعان، ماهرون إذ أن ليس من السهل مد خط من القدس إلى تل أبيب، من التجربة عرفت كم كان الأمر صعبا: ذات مرت مددت سلكا من غرفتي إلى غرفة إلياهو فريدمن على بعد دارين وساحة من بيتنا، سلك رفيع ومتين، ورشة كاملة، الأشجار في الطريق، والجيران، مخزن، جدار، درج وشجيرات. بعد أن انتظر قليلا، كان أبي يخمن بأن مدير البريد أو السيّد النشاشيبي قد أنهيا مكالمتهما، فكان يرفع السماعة ويقول لعاملة المقسم: "عفوا، يا سيدتي، أظنني قد طلبت الاتصال بتل أبيب 648." فكانت تقول: "سجلت طلبك أمامي، أيها السيّد، رجاء الانتظار" (أو "أرجو أن تتحلّى بالصبر"). فكان أبي يقول: "أنا انتظر، يا سيدتي، بالطبع أنني انتظر ولكن هناك أشخاص ينتظرون أيضًا على الطرف الآخر." وبذلك كان يلمّح لها بأدب بأننا حقا أناس حضاريون ولكن يوجد حد للصبر وضبط النفس. صحيح أننا أناس مؤدّبون جدًًّا ولكننا لسنا ساذجين يمكن الضحك علينا؛ لسنا غنما تقاد إلى المسلخ لذبحها. لقد انتهت وإلى الأبد إمكانية أن ينكّل أي شخص باليهودي وأن يفعل به كلّ ما يحلو له. وعندها كان التلفون يرن فجأة هناك في الصيدلية، وكان هذا دائمًا رنينا صاخبا يرجف له القلب ويقشعرّ له الظهر، لحظة سحرية خارقة، وكانت المكالمة تتم على النحو التالي تقريبا: " هالو تسفي؟" "يتكلّم." "هذا آرييه. من القدس." "نعم آرييه، تحياتي، هنا تسفي، كيف حالكم؟" "عندنا كلّ شيء على ما يرام. نحن نكلمكم من الصيدلية." "ونحن كذلك. ما الجديد؟" "لا جديد. كيف الحال عندكم؟ ماذا تقول؟" "كلّ شيء على ما يرام. لا شيء خاصّ. عائشون." "إذا لم يكن هناك أي جديد، فهذا جيد. لا جديد عندنا أيضًا. نحن جميعا بخير. كيف الحال عندكم؟" "كذلك." "جيد جدًًّا. إذن الآن ستكلمكم فانيا." ومرة أخرى نفس الشيء: كيف حالكم؟ ما الجديد؟ وبعد ذلك: "الآن عاموس سيكلمكم عدة كلمات." كانت هذه هي المكالمة كلها. كيف الحال؟ جيدة. إذا كان الأمر كذلك سنكلمكم ثانية قريبا. ما أجمل أن نسمع صوتكم. ما أجمل أن نسمع صوتكم أنتم أيضًا. سنرسل إليكم رسالة نحدد موعدا للمكالمة في المرة القادمة. سنتكلم. نعم. بالطبع سنتكلم. قريبا. إلى اللقاء. حافظوا على أنفسكم. نتمنى لكم كلّ الخير. نتمنى لكم أنتم أيضًا كلّ الخير. |

|
|
|
#6 |
|
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
إلا أن هذا لم يكن مضحكا: فالحياة كانت معلقة بخيط رفيع. الآن أنا أدرك بأنهم لم يكونوا متأكدين إذا كانوا سيتكلمون فعلا مرة أخرى، أم لا، ربما هذه هي المرة الأخيرة، إذ من يدري ماذا سيحدث، هل ستحدث اشتباكات، تحدث مذبحة، مجزرة، يقوم العرب ويذبحوننا جميعا، تندلع حرب، تحدث كارثة، أولم تصل مدرعات هتلر إلى عتبتنا من جهتين: من شمال أفريقيا وكذلك عبر القفقاز، من يدري ما الذي بانتظارنا. هذه المكالمة الفارغة ليست فارغة إطلاقا - لكنها كانت هزيلة.
الشيء الذي تنوّرني به الآن تلك المحادثات التلفونية هو كم كان من الصعب عليهم – على الجميع، وليس على والديّ فقط - أن يعبّروا عن مشاعرهم الخاصة. في التعبير عن الشعور العام لم تواجههم أية صعوبة- فقد كانوا أناسا حساسين، وأحسنوا التعبير. أواه كم أحسنوا التعبير، كانوا قادرين على أن يتناقشوا ثلاث - أربع ساعات بحماس كبير حول نيتشه، ستالين، فرويد، جابوتنسكي، وأن يضعوا في ذلك كلّ قوّتهم، وأن يصلوا إلى دموع الشفقة، وأن ينشدوا الأناشيد، حول الاستعمار، واللاسامية، والعدالة، و"قضية الأراضي"، وحول "قضية المرأة"، وحول "قضية الفن إزاء الحياة". ولكنهم في اللحظة التي حاولوا فيها التعبير عن شعور خاصّ، صدر عنهم شيء منكمش، مقفر، وربما حتى مرعوب، والذي هو ثمرة أجيال تلو أجيال من الكبت والتحريم. تحريم مضاعف، منظومتان من الكوابح: ضاعفت الأعراف الأوروبية البرجوازية من قوّة القيود التي فرضتها البلدة اليهودية المتدينة. كلّ شيء تقريبا كان "ممنوعا" أو "غير مألوف" أو "غير لائق". بالإضافة إلى ذلك كان هناك نقص كبير في الكلمات: لم تصبح اللغة العبرية بعد لغة طبيعية بما فيه الكفاية، وبالتأكيد لم تصبح بعد لغة حميمية، كان من الصعب أن تعرف ماذا يبدر منك عندما كنت تتكلم العبرية. لم يكن الناس واثقين أبداً بأنه لن يصدر عنهم شيء سخيف، ومن السخف كانوا يخافون ليل نهار. خافوا حتى الفزع. حتى أن أشخاصا كوالديّ الذين أتقنوا العبرية جيدا، لم يتمكّنوا منها بشكل عملي.كانوا يتكلمون العبرية وهم يرهبون الوقوع في الخطأ، يتراجعون أحيانًا كثيرة ويصوغون من جديد ما قالوه لتوهم: ربما هكذا يشعر سائق قصير النظر وهو يتحسس طريقه في الليل في شبكة الطرقات الضيقة لمدينة غريبة في سيارة لم يسقها من قبل. ذات مرة، جاءت لضيافتنا يوم سبت، صديقةٌ لأمّي تعمل معلمة اسمها ليليا بار سمخا. دار حديث، وكانت الضيفة تقول دائمًا "أنا أضرط خوفاً" ومرة أو مرتين قالت أيضًا "كان يضرط خوفاً" وقد انفجرت بالضّحك وهم لم يفهموا ما المضحك، أو أنهم فهموا وتظاهروا بأنهم لا يفهمون. كذلك كان الأمر عندما قالوا بأن العمّة كلارا دائمًا "تخرأ" البطاطا المقلية، وكذلك عندما تحدّث أبي عن سباق التسلّح بين الدول العظمى أو عبر عن معارضة غاضبة لقرار دول حلف الناتو البدء في تسليح
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
والدي، من جهته، كان يتجهم وجهه في كلّ مرة كنت استعمل فيها بكلمة "يدبّر" وهي كلمة ساذجة تماما تخلو من أي تورية، ولكنني لم افهم، ولو لمرة واحدة، لماذا كانت هذه الكلمة تثير غضبه، وهو بالطبع لم يشرح، ولم يكن بالحسبان أن أسأله. بعد سنوات علمت بأنه قبل ولادتي، في الثلاثينيات، كانت كلمة "يدبّر" تعني يحبّل المرأة، وليس هذا فحسب بل يحبلها ولا يتزوجها. على ما يبدو أنهم ببساطة قصدوا، أحيانًا، في التعبير "يدبّرها" القول بأنه ضاجعها: "في تلك الليلة في مشغل تغليف البرتقال دبّرها مرتين، وفي الصباح تظاهر، الحقير، بأنه لا يعرفها إطلاقا." ولذلك إذا قلت بـ"أن أوري دبّر أخته" كان وجه أبي يتجهم وينكمش قليلا منبت أنفه. من المؤكد بأنه لم يشرح ذلك إطلاقا- وهل كان ذلك ممكنا؟ في اللحظات الخصوصية لم يتحدثا بينهما باللغة العبرية. ولربما في اللحظات الخصوصية جدًًّا لم يتكلما إطلاقا. صمتا. عاش الجميع في ظل الخوف من أن يُرى أو يسمع شيء سخيف. |

|
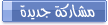
 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
الساعة بإيدك هلق يا سيدي 20:03 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)






